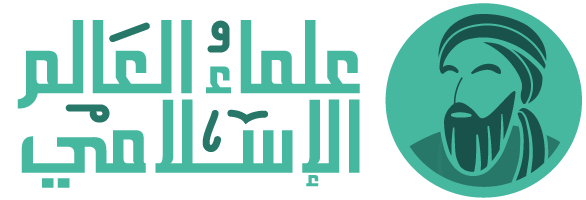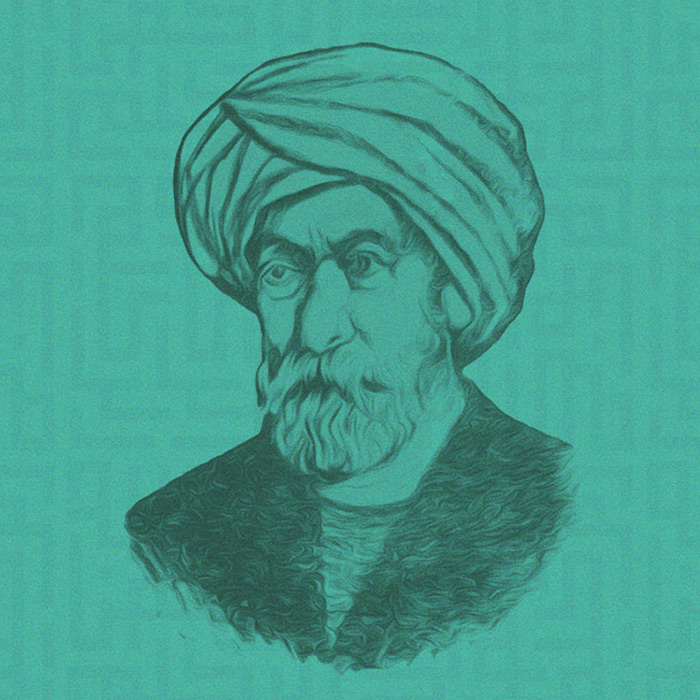
أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني الذهلي المروزي البغدادي، فقيهٌ ومحدِّث، رابعُ الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، يأخذ مذهبُه طابع أهل الحديث، مثل مذهب الإمام مالك. اشتُهر أحمد بن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به وعُرفت باسم "فتنة خلق القرآن". ...السيرة الذاتية
أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني الذهلي المروزي البغدادي، فقيهٌ ومحدِّث، رابعُ الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، يأخذ مذهبُه طابع أهل الحديث، مثل مذهب الإمام مالك. اشتُهر أحمد بن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به وعُرفت باسم "فتنة خلق القرآن". ...السيرة الذاتية
نشأ الإمام أحمد بن حنبل يتيمًا شأنه في ذلك شأن شيخِه الإمام الشافعي، فكان على عاتق أمِّهِ وأسرة أبيه مهمة تربيته، ولحسن حظه ورث عن أبيه ببغداد منزلًا يسكنه مع أمه، وحوانيت (دكاكين) تُدرّ عليه دخلًا يُتيح له كَفافَ العيش، فاستغنى بهذا الدخل عن مساعدة الناس. ومنذ طفولته تميَّز الإمام أحمد بصفات الرجولة، والصبر والجِد، والاهتمامِ بالعمل، وقدرته على تحمُّل المشاق حتى نال ثقةَ جميعِ مَن عرفه من رجالٍ ونساء، وفوق ذلك اُشتهر بذكائه واستقامته، حتى إنَّ الآباء اتخذوه قدوةً لأبنائهم. وكان الإمام أحمد رجلًا ذا هيبةٍ ووقار، موصوفًا بطول القامة أو اعتدالها، وسُمرةٍ مع وجهٍ حسن، قوي الحافظة، صبورًا، نزيهًا، عفيف النفس، وكان زاهدًا ورعًا يرفض عطايا الناس والخلفاء، ولم يسعَ وراء منصبٍ دنيويّ، فكان مثلًا يُحتذى في الدين والأخلاق. شهدت بغدادُ بداياته في طلب العلم، حيث كانت المدينة منارةً للعلم والمعرفة في شتى المجالات، من علوم الدين واللغة إلى الرياضيات والفلسفة والتصوف. حفظ القرآن وهو صغير، وطلب علم الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، في العام الذي مات فيه الإمام مالك، ثم اتجه في بداية طلبه للعلم للفقهاء الذين جمعوا بين الرأي والحديث، وكان القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل شيوخ الإمام أحمد في رحلته العلمية، ولكنه مال بعد ذلك إلى المحدِّثين الذين انصرفوا إلى دراسة الحديث وتدوينه. سافر الإمام أحمد بن حنبل في رحلاتٍ متعددةٍ طلبًا للحديث في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فزار العراق والحجاز والشام والبصرة والكوفة، وكانت بداية رحلاته سنة 186هـ، وجمع خلال هذه الرحلات مُسندًا ضخمًا، ضم الأحاديث النبوية الشريفة التي تلقاها من علماء تلك البلدان. التقى الإمامُ أحمد في بداية شبابه بالشافعي في موسم الحج، فكان الشافعي يروي الحديث عنه ويقول "أنتم أعلم بالحديث منا". واصل أحمد بن حنبل رحلته في جمع الأحاديث النبوية، وبدأ بعملية غربلةٍ دقيقةٍ لتلك الأحاديث، ليُسجِّل في كتابه "المُسنَد الأعظم" أربعين ألف حديث، وبرز من بين تلاميذ حلقته العلمية أسماءٌ لامعةٌ، مثل البخاري ومسلم وأبو داود، مما يؤكد على مكانته العلمية المرموقة. وباجتماع السُنة للإمام أحمد، وتتلمذه على يد الإمام الشافعي على مدى خمسة عشر عاما، وبدراسة فقه أبي حنيفة من كتب محمد بن الحسن وأبي يوسف اكتملت له المصادر الأساسية للإحاطة بالفقه، وكان مع ذلك متّبعًا لآثار الصحابة والتابعين في كل شئون حياته؛ وهو ما طَبع شخصيته بالورع الذي تجلى في أصول فقهه. وفي سنة 204 هـ انطلق المجلس العلمي للإمام أحمد في بغداد، وهي السَّنة التي توفي فيها الإمام الشافعي بالقاهرة، وكان الإقبال على درسه شديدًا حدَّ الزِّحام، حتى ليَذكرُ بعضُ الرُّواة أنَّ المستمعين لدرسه في المجلس الواحد بلغ خمسة آلاف، وليس هذا العدد يُقصد بذاته، وإنما يَدل على العدد الكثيف الذي كان في مجلس الإمام، مما أدى إلى كثرة رُواة فقه الإمام أحمد. روى ابنُ الجوزي أنَّ أحدَ معاصري الإمام أحمد؛ قال "اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل اثنتي عشرة سنة، وهو يقرأ المُسنَد على أولاده، فما كتبت منه حديثًا واحدًا، وإنما كنت أميل إلى هَدْيه وأخلاقه وآدابه". وكان للإمام أحمد مجلسان للدرس والتحديث؛ أحدهما في منزله يُحدِّث فيه خاصة تلاميذه وأولاده، والثاني في المسجد يَحضر إليه العامةُ والتلاميذ، وقد كان وقتُ درسه في المسجد بعدَ العصر؛ أي قبل عَتمة الليل وبعد وهج النهار. يسودُ مجلسَه الوقارُ والسكينة مع تواضعٍ واطمئنانٍ نفسي، ولا يُلقي درسَه من غير طلب، بل يسأل عن الأحاديث المروية في موضوعٍ ما؛ فيَستحضر الكتبَ التي دَوَّن فيها تلك الأحاديث، كما كان إذا قال حديثًا مرويًّا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يقوله إلا من كتابٍ؛ حِرصًا على جودة النقل، وإبعادًا لمَظنة الخطأ ما أمكن، وفي الأحوال النادرة جدًا كان يقول الحديث من غير رجوعٍ إلى كتاب. وكان أحمدُ لا يشارك في التناحرات السياسية والفكرية والاجتماعية، وإنما اختار لنفسه منهج الاتباع لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والصحابة والصفوة من التابعين، ولم يكن يستجيز لنفسه أنْ يرُد على أيِّ موضوعٍ مُثارٍ في عصره من علماء الكلام، أو يفتي في مسألةٍ لم ترِد في كتابٍ أو سُنة، أو لم يعرفها الصحابة، ويكتفي بأن ينقل رأيهم فيها حريصا على ألا يَقْفُ (يَتَّبِّع) ما ليس له به علم، حتى لا يخرج عن نهج السلف، ويَضل في متاهات العقل البشري. أما عن فتاواه الفقهية التي كان يُضطر إلى استنباطها؛ فكان لا يسمح لتلاميذه أن يدونوها ولا أن ينقلوها عنه، بل كان يكره ذلك. لم يتزوج الإمام أحمد إلا بعد أن بلغ الأربعين، ولعلَّ طلبَ العلم شغله عن الزواج، أو لأنه كان كثير الترحال وتطول غيبته عن بلده، فلمَّا بلغ الأربعين وأصبح أقرب إلى الاستقرار من ذي قبل فكَّر في الزواج، وقال ابن الجوزي في ذلك "كان رضي الله عنه شديد الإقبال على العلم، سافر في طلبه السفر البعيد، ووفَّر على تحصيله الزمان الطويل، ولم يتشاغل بكسبٍ ولا نكاحٍ حتى بلغ منه ما أراد". وكانت أولى زوجاته هي "العباسة بنت الفضل"، عاشت معه ثلاثين سنة، وأنجبت منه ولدهما صالحًا، وقد قال المَرُّوذِي تلميذ أحمد بن حنبل في شأن العباسة "سمعتُ أبا عبد الله يقول: أقامت معي أمُّ صالحٍ ثلاثين سنة فما اختلفتُ أنا وهي في كلمة"، ولما توفيت أمُّ صالحٍ تزوج أحمد زوجته الثانية رَيحانة، فأنجبت منه ولدًا واحدًا هو عبد الله. فلما ماتت أمُّ عبد الله اشترى جاريةً اسمُها "حُسْن"، فأنجبت له "زينب" ثم توأمين هما "الحسن والحسين"، فماتا بعد ولادتهما، ثم ولدت "الحسن ومحمد"، ثم ولدت بعد ذلك "سعيدًا"، وقد نَبَغَ في الفقه من أولاده "صالحٌ وعبدُ الله"، وأما سعيدٌ فقد وَلِي قضاءَ الكوفة فيما بعد. أثنى عليه الكثيرُ من العلماء والمصلحين المعاصرين له، ومن ثنائهم؛ قولُ حرملة "سمعتُ الشافعي يقول "خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل"، وقال المُزَني: قال لي الشافعي "رأيت ببغداد شابًا إذا قال "حدثنا" قال الناسُ "صدق" قلتُ: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل". وعن الشافعي أنه قال "أحمدُ إمامٌ في ثمانِ خصال: إمامٌ في الحديث، إمامٌ في الفقه، إمامٌ في القرآن، إمامٌ في اللغة، إمامٌ في السنة، إمامٌ في الزُّهد، إمامٌ في الورع، إمامٌ في الفقر". واجه الإمامُ أحمد بن حنبل محنةً صعبةً بسبب رفضه القولَ بخلق القرآن، فبينما كان الخليفة المأمون يُجبر الفقهاء والمحَدِّثين على تأييد هذا الرأي، حتى رضخ له كثيرٌ منهم، تمسك ابنُ حنبل بقوله أنَّ القرآنَ كلامُ الله ليس بمخلوق، مما عرَّضه للأذى والاضطهاد والسجن. مات الخليفة المأمون ولكن لم تنته فتنةُ خَلق القرآن بموته، بل اشتدت وذلك لسببين: الأول وهو وصية المأمون لأخيه المعتصم بالاستمساك بدعوته في مسألة خلق القرآن، والسبب الثاني هو وصيته بالاستمساك بأحمد بن أبي دُؤاد، وهو صاحب فكرة حَمل الناس على تلك العقيدة بقوة السلطان، ولم يكن المعتصم رجل علمٍ بل رجل سيفٍ وقتال، فترك أمرَ خلق القرآن لأبي دؤاد؛ لينفذ وصية أخيه. أُعيد الإمام أحمد مرةً أخرى إلى السجن، فكانت جملة الفترة التي قضاها بالسجن ثمانية وعشرين شهرًا، وأطلقوا سراحه سنة 220 هـ، وبعد أن عاد أحمد إلى بيته مكث فيه حتى التئمت جراحه، ثم نزل مرة أخرى إلى الناس ليحدثهم بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وظل يُدَرِّس في المسجد حتى مات المعتصم. ولما تولى الواثقُ الحكمَ أعاد المحنة على أحمد بن حنبل، غير أنَّه لم يُعده للسجن، ولم يأمر بضربه بالسِّياط كما فعل المعتصم، إذ رأى أنَّ ذلك زاده منزلة عند الناس، ومنع عامة الناسَ من قبول فكرة خلق القرآن لتعاطفهم مع الإمام أحمد؛ فقال الواثق له «لا تجمعنَّ إليك أحدًا ولا تُساكنِّي في بلدٍ أنا فيه»، فأقام ابن حنبل مختفيًا لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها، حتى مات الواثق، وبذلك يكون أحمد بن حنبل قد انقطع عن الدرس مدةً تزيد عن خمس سنوات، ثم بعد ذلك زالت هذه المحنة بالكلية في عهد الخليفة المتوكل ابن المعتصم، الذي أكرم الإمام أحمد بن حنبل وقدّمه، ومكث مدةً لا يولِّي أحدًا إلا بمشورته. وفي ربيع الأول من سنة 241 هـ، ألمَّ بالإمام أحمد بن حنبل مرضُ الموت، وتوافد عليه كبارُ الناس لعيادته، حاملين مشاعر الود والتقدير لعلمه وفضله، ولكن شاءت الأقدار أن تُفارق روحُه جسدَه الطاهر يوم الجمعة، وخرج الناسُ في موكبٍ جنائزيٍّ مَهيب، يملأ الشوارع والطرقات، حاملين جثمانه الطاهر، داعين له بالرحمة والمغفرة، وقد شارك في جنازته نائبُ الخليفة محمدُ بنُ طاهر، واقفًا بين الناس يشاركهم حزنَهم على فقيد الإسلام الجليل.
تعليق
علماء قد تهمك

الجغميني
ت: كان حيًّا 618 هـ | الدولة الخوارزمية

كمال الدين ابن العديم
ت: 660 هـ | عربي الأصل | الدولة الأيوبية و دولة المماليك البحرية
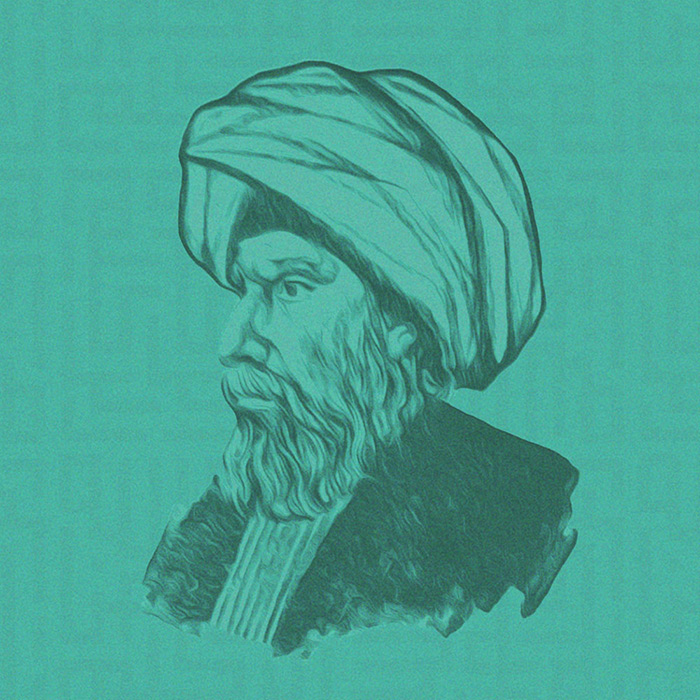
الإمام الشافعي
ت: 204 هـ | عربي الأصل | العصر العباسي

حنين بن إسحاق
ت: 260 هـ | العصر العباسي
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد