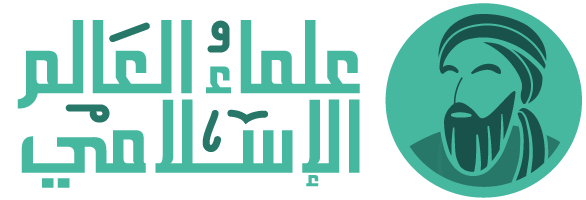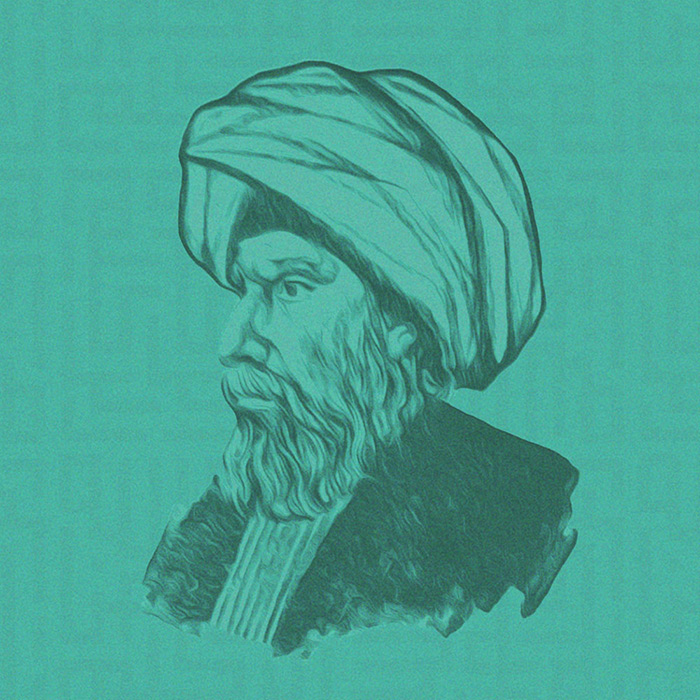
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المكي، ولد في نفس العام الذي توفى فيه أبو حنيفة، ففي هذا العام توفى إمام وولد إمام، وحفظ القرآن في صباه ثم قرأ الموطأ في المدينة على الإمام مالك، ثم سافر إلى العراق والتقى بأصحاب أبي حنيفة، وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن ونشر مذهبه القديم هناك، ثم بعد ذلك نزل الفُسطاط ونشر علمه بين المصريين وكوَّن مذهبه الجديد، وهو أول من أَلَّف في علم أصول الفقه. ...السيرة الذاتية
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المكي، ولد في نفس العام الذي توفى فيه أبو حنيفة، ففي هذا العام توفى إمام وولد إمام، وحفظ القرآن في صباه ثم قرأ الموطأ في المدينة على الإمام مالك، ثم سافر إلى العراق والتقى بأصحاب أبي حنيفة، وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن ونشر مذهبه القديم هناك، ثم بعد ذلك نزل الفُسطاط ونشر علمه بين المصريين وكوَّن مذهبه الجديد، وهو أول من أَلَّف في علم أصول الفقه. ...السيرة الذاتية
جمعه البويطي، وبوبه الربيع بن سليمان.
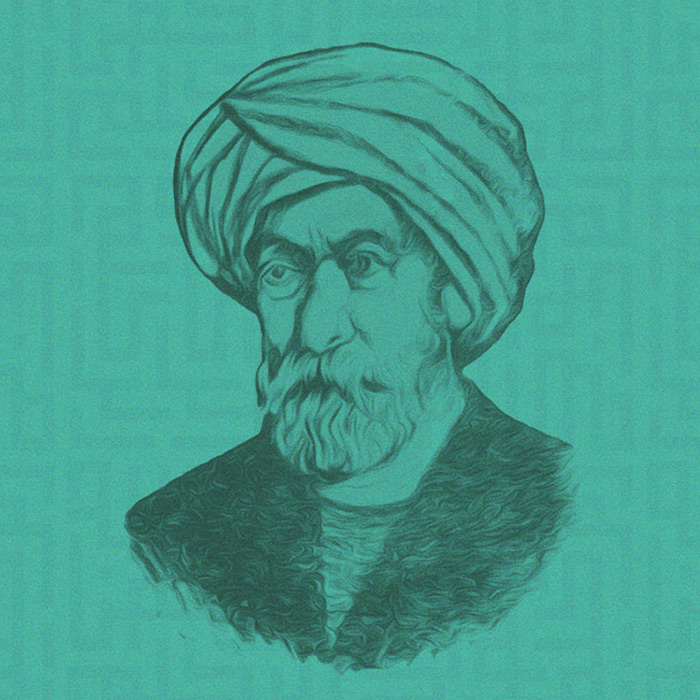

ولد الإمام الشافعي في غزة ثم انتقلت به والدته إلى مكة المكرمة؛ خشية ضياع نسبه الشريف بعد وفاة والده حينما كان في الثانية من عمره، حفظ القرآن الكريم في صغره ثم رحل إلى قبائل هُذَيل في بادية العرب المعروفين بفصاحة لسانهم، فاستفاد منهم وحفظ كثيرًا من أشعارهم، واشتُهرت فصاحة الشافعي حتى ضُرب به المثل، وبلغ شأنه في اللغة العربية مبلغًا عظيمًا حتى إنَّ الأصمعي أحد كبار علماء اللغة العربية قال عنه "صُحِّحَتْ أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي". تطلع الشافعي إلى المدينة بعد أن احتوى علم مكة؛ قاصدًا الأخذ عن الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنه) إمام دار الهجرة، وقبل أن يذهب إلى الإمام مالك سعى للحصول على كتاب "الموطأ"، واستعاره من رجل بمكة فحفظه، وحمل الشافعي معه كتابَي توصية من والي مكة إلى والي المدينة وإلى الإمام مالك. وكان الإمام مالك لديه فراسة، فحينما نظر إلى الشافعي قال له "يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شَأنٌ من الشأن، إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بالمعصية"، ثم قال له مالك "إذا ما جاء الغد تجيء إليَّ، ويجيء معك ما يقرأ لك"، يقول الشافعي: "فغدوت عليه، وابتدأت أقرأ ظاهرًا؛ (أي من حفظه دون أن ينظر في كتاب الموطأ) والكتاب في يدي، فكلما تهيبت مالكًا، وأردت أن أقطع قراءتي، أعجبه حسن قراءتي، وإعرابي، فيقول لي: يا فتى زد، حتى قرأته عليه في أيام يسيرة". بعد ذلك لازم الشافعي الإمام مالك يناقش معه المسائل الفقهية، ويستفيد من علمه حتى توفي الإمام مالك وكان الشافعي قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. كان الإمام مالك يرى أن العلم أمانة يجب أن تُنشر، وأن توفير احتياجات الطلاب واجب لضمان استمرارهم في طلب العلم، وبعد وفاته واجه الشافعي صعوبة في توفير احتياجاته الأساسية، فاضطر للبحث عن عمل يُؤمّن له قُوْتَه ليتمكن من مواصلة طلب العلم، وخلال رحلة والي اليمن إلى مكة، التقى ببعض القرشيين الذين ناقشوا معه أمر الإمام الشافعي، ونتيجة لهذه النقاشات قرر الوالي اصطحاب الشافعي معه إلى اليمن، لكن الشافعي لم يكن يملك تكاليف السفر، فساعدته أُمُّه بِرَهْن دارها في مكة لتمكينه من السفر مع الوالي. وفي نجران؛ تولى الإمام الشافعي منصب القضاء، وسعى جاهدًا لترسيخ دعائم العدل بين أهلها، وكان من بينهم قوم اعتادوا التملق والتزلف للولاة والقضاة، إلا أنهم لم يجدوا لدى الشافعي أي قبول لمثل هذه الممارسات، مما أثار حنقهم ودفعهم إلى تدبير المؤامرات ضده لدى والي اليمن، فتعاون الوالي معهم وسعى للإيقاع به، حتى نجحت وشايته في النهاية لدى الخليفة العباسي ببغداد. عاشت الدولة العباسية في بغداد تحت وطأة الخوف من خصومهم العلويين، واتبعوا سياسة القضاء على أي دعوة علوية في مهدها، فاستغل والي اليمن هذا الضعف، واتهم الإمام الشافعي – أحد أحفاد المطلب بن عبد مناف – بالانتماء إلى العلويين والتآمر ضد الدولة، فأرسل إلى الخليفة هارون الرشيد يقول "إن تسعة من العلويين تحركوا، وإني أخاف أن يخرجوا بالثورة، وإنَّ ها هنا رجلًا من أولاد شافع المطلبي، لا أمر لي معه ولا نهي، يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه". فأرسل الرشيد إلى والي اليمن يأمره بإرسال هؤلاء العلويين التسعة إليه، ومعهم ذلك الشافعي المطلبي، وكاد أن يُقتل الشافعي، لولا حجة الشافعي بين يدي هارون الرشيد، وبهذا نجا الشافعي من القتل ظلمًا، ومرت المحنة الأولى على الشافعي، وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، سنة 184 هـ/ 800م. وأدرك الشافعي من هذه المحنة أن عليه أن يتجه إلى العلم، لا إلى الولاية وخدمة شئون السلطان، وصار ضيفا مقيمًا على الفقيه "محمد بن الحسن" حامل فقه العراقيين وناشره. لم يذكر أحد من الرواة كم لبث الشافعي في بغداد، ويُظن أن إقامته كانت طويلة ربما تجاوزت السنَتَين يقرأ فيها كتب "محمد بن الحسن"، ويناظر العلماء والفقهاء والمحَدِّثين، ويأخذ العلم عن الشيوخ، فاجتمع له فقه الحجاز الذي يغلب عليه النقل، وفقه العراق الذي يغلب عليه العقل. وطوال إقامة الشافعي ببغداد، أكرم "محمد بن الحسن" منزلة الشافعي، بل إنه كان يفضل مجلس الشافعي على مجلس الخليفة، وكانت لمحمد بن الحسن حلقة درس، وكان الشافعي - وهو من أصحاب مالك وفقهاء مذهبه - من عادته إذا غادر ابن الحسن مجلسه، أن يناظر أصحابه، مدافعًا عن فقه الحجاز، وطريقة الحجاز في الفقه. وحين عرف ابن الحسن أن الشافعي يناظر أصحابه ولا يناظره هو دعاه إلى مناظرته، فاستحيا الشافعي وامتنع، فأصر ابن الحسن فناظره الشافعي مُستكرَهًا في مسألة الشاهد واليمين فلم يفسد ذلك ودًّا بينهما، ومنذ ذلك اليوم ظل الشافعي يناظر ابن الحسن وأصحابه معًا إلى أن غادر بغداد عائدًا إلى مكة، وقد تكون إقامته طالت إلى حين وفاة محمد بن الحسن سنة 189 هـ/ 805م، أو قبلها بقليل. في مكة أخذ الشافعي يلقي دروسه في الحرم المكي، وفي موسم الحج كان يلتقي به أكابر العلماء، ومن بينهم الإمام أحمد بن حنبل، وظهر الشافعي بفقه جديد مزج فيه بين فقه أهل الحجاز وفقه أهل العراق؛ أي بين فقه النقل وفقه العقل، واتجه الشافعي إلى الاجتهاد المطلق. جاوزت شهرة حلقة الشافعي حدود مكة، فبلغت العراق وعرف علماؤه قيمة ما ينشره بين الناس من علم، وهذا ما دعا حافظ العراق الإمام "عبد الرحمن بن مهدي" أن يكتب إلى الشافعي يطلب منه أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة، وحين انتهى الشافعي من إنجازه لهذا الكتاب، سافر به لعرضه على جمهرة الفقهاء في بغداد من أهل النقل والعقل سنة 195 هـ/ 811م. ولم تتجاوز هذه الرحلة السنتين، وكانت حصيلة جهده العلمي في هذه المرحلة أنه حاول تعريف المحدثين بطريقة فهم السنة واستنباط الأحكام منها، وكَفَّ مغالاة أهل الرأي بمناظرته لهم، ونَشَر مذهبه الذي جمع خير ما في الطريقتين. عاد الشافعي إلى مكة ليبث فيها علمه، إلا أنه لم تطل إقامته فيها حتى عاد إلى بغداد مرة أخرى، وكان ذلك في سنة 198هـ/ 814م، وأقام فيها نحو ثمانية أشهر، وقيل شهرًا واحدًا ولم يُؤْثر عن الشافعي في هذه الرحلة الثالثة شيء جديد غير ما أقامه في رحلته الثانية. رجع الشافعي إلى مكة ولكنه لم يمكث طويلًا، فقد شاءت الأقدار أن ينتقل إلى مصر في عام 199 هـ، وهناك نزل على أخواله من قبيلة الأزد، والسبب المرجح لهجرة الشافعي من بغداد إلى مصر، هو التغيُّرات السياسية وسيطرة الفكر المعتزلي خاصة بعد تولي المأمون الخلافة، واعتذار الشافعي له عن تولي أمر القضاء، فلعله خشي أن يتكرر هذا العرض وأن يواجه مصيرًا كمصير أبي حنيفة عند أبي جعفر المنصور، فلم يجد ملاذًا آمنًا إلا في مصر، فواليها قرشي هاشمي وليس معتزليًّا". وحين قدم الشافعي مصر كان السائد فيها مذهب مالك، والقليل من العلماء على مذهب أبي حنيفة، فما لبث أن أقبل عليه الناس، فاستمعوا له وأحبوه، ثم ما زال فيهم ينشر أصوله وآراءه الفقهية، ويستنبط الأحكام ويؤيدها بالأدلة، حتى اجتمع الناس عليه، وأخذوا بقوله، وتمذهبوا بمذهبه. ولم يتناول الشافعي آراء شيخه مالك بالنقد أو التزييف؛ ولذلك كان يعد من أصحاب مالك، ثم حدث ما اضطر الشافعي إلى أن يَنقد آراء مالك، ويكشف ما فيها من خطأ في رأيه، فقد بلغه أن الإمام مالك تُقدَّس آثاره وثيابُه في بعض البلاد الإسلامية، وأن بعض المسلمين يعارضون أحاديث للرسول (صلى الله عليه وسلم) بأقوال مالك. فأدرك الشافعي أن الناس مُقْدِمون على أمرٍ خطيرٍ، تصبح به أقوال مالك دينًا داخل الدين، فمالك يصيب ويخطئ، فألف الشافعي كتابًا بعنوان "خلاف مالك"، وكان يقول "كرهت أن أفعل ذلك، ولكني استخرت الله فيه سنة"، ولذلك ثار المالكية على الشافعي، وذهب جماعة منهم إلى الوالي طالبين إخراج الشافعي من مصر، فدافع عنه الوالي بأنه لم ينقد مالكًا فقط، وإنما نقد من قبله آراء العراقيين، ونقد آراء الأوزاعي فقيه الشام. وجدير بالذكر أن الشافعي كانت له بعض الآراء الجديدة التي تخالف آراءَه التي نشرها في مذهبه القديم بالعراق، وليس صحيحًا أنه بدَّل جميعَ أقواله أو أكثرها، وإنما بدل بعضها. وثناء العلماء على الإمام الشافعي لا يُحصى، نذكر منه ما روي عن الإمام أحمد قوله "إنَّ الله تعالى يبعث في رأس كل مائة سنة رجلا يعلم الناس دينهم"، فقال "كان في المائة الأولى: عمر بن عبد العزيز وفي المائة الثانية الشافعي"، ثم قال: وإني لأدعو للشافعي في صلاتي منذ أربعين سنة، وأستغفر الله له، ويروى عنه أيضا قوله: كان الفقه قُفْلًا على أهله، حتى فتحه الله بالشافعي. كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح. فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث يجالسونه فيسألونه عن تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، وحضر قومٌ للمناظرة ثم يتفرقون، ثم يجيء أهل العربية والعَروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف إلى بيته، ومع ذلك يعتبر الشافعي أقل الأئمة الأربعة عمرا؛ حيث عاش 54 سنة.
تعليق
علماء قد تهمك

الجغميني
ت: كان حيًّا 618 هـ | الدولة الخوارزمية

عبد الرحمن الجبرتي
ت: 1240 هـ | عربي الأصل | العصر العثماني و عصر أسرة محمد علي

داوود الأنطاكي
ت: 1008 هـ | العصر العثماني

أمة الواحد بنت المحاملي
ت: 377 هـ | عربي الأصل | العصر العباسي
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد