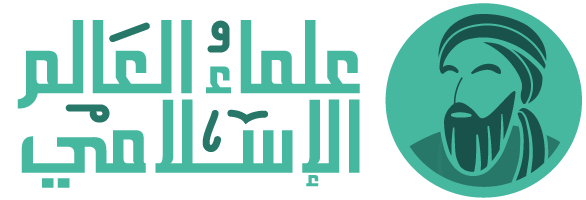محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، وتتلخص رسالة حياته في أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة للشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. ...السيرة الذاتية
محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، وتتلخص رسالة حياته في أمرين: الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة للشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. ...السيرة الذاتية
لم يتمه.
سواء في المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها، أو فيما تنشره الجرائد أو في المراسلات بين الناس.
كان له الفضل في عودة الشيخ محمد عبده للدراسة بالجامع الأزهر
كان بيت والده يلقب ببيت التركمان لأن نسبه ينتهي إلى جدٍّ تركماني، أما بيت والدته فيقال إنه عربي قرشي، وإنه يتصل في النسب بعمر بن الخطاب، ولكن ذلك كله روايات متوارثة لا يمكن إقامة الدليل عليها. بدأ محمد عبده في تلقي تعليمه الأولي للقراءة والكتابة ببيت والده، ثم حفظ القرآن في سنتين، وبعد ذلك ذهب إلى الجامع الأحمدي بطنطا؛ ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم، وبدأ الإمام يتلقى أول دروسه الأزهرية في الجامع الأحمدي بعد أن استكمل تجويد القرآن، ثم قضى نحو سنة ونصف متعثرا في تحصيل العلم بسبب طريقة التعليم فتسرب إليه اليأس، وهرب من الدروس واختفى عند أخواله ثلاثة أشهر إلى أن عثر عليه أخوه، فأخذه إلى المسجد الأحمدي وأراد إكراهه على طلب العلم، إلا أن رغبة الإمام محمد عبده في ذلك الوقت هي ترك طلب العلم والاشتغال بالزراعة؛ فرجع إلى محلة نصر وتزوج، ولكن والده رفض تلك الفكرة وقرر إعادته إلى الجامع الأحمدي. وحينها قرر الشيخ محمد عبده الهروب إلى أخوال أبيه، في بلدة كنيسة أورين من أعمال مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وفيها التقى بالشيخ درويش والذي كان له تأثير كبير في حياته العلمية، إذ كان الشيخ درويش صوفيًّا، فألقى إليه ببعضٍ من حِكَم التصوف، وقاده على شيء من سلوك الصوفية، فعادت إليه الرغبة في طلب العلم. يقول الإمام محمد عبده "وهناك صادفتُ في مَهربي من علمني كيف أطلب العلم من أقرب وجوهه، فذقت لذته واستمررت في طلبه"، ويقول عنه أيضًا "لم يأت عليَّ اليوم الخامس إلا وقد صار أبغض شيء إليَّ ما كنت أحبه من لعب ولهو، وفخفخة وزهو، وعاد أحب شيء إليَّ ما كنت أبغضه من مطالعة وفهم، وكرهت صور أولئك الشبان الذين كانوا يدعونني إلى ما كنت أحب ويزهدونني في عِشرة الشيخ رحمه الله، فكنت لا أحتمل أن أرى واحدا منهم، بل أفر من لقائهم جميعًا كما يفر السليم من الأجرب". ذهب الإمام محمد عبده إلى القاهرة ليطلب العلم الشرعي بالجامع الأزهر، في منتصف شوال سنة 1282هـ / 1866م، وكان بالأزهر يومئذ حزبان: شرعيٌّ محافظ، وحزبٌ صوفي أقل في محافظته من الشرعيين، وحضر محمد عبده دروس كلٍّ من الحزبين، فسمع من الحزب الشرعي المحافظ دروس المشايخ عليش والرفاعي والجيزاوي والطرابلسي والبحراوي، ولكنه انتمى إلى الحزب الصوفي وكان رائده الشيخ حسن رضوان، وكان من هذا الحزب أيضا الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني. وكان الإمام محمد عبده حريصا على العزلة والبعد عن الناس، وفي أواخر كل سنة دراسية كان يذهب إلى محلة نصر ليقيم بها شهرين من منتصف شعبان إلى منتصف شوال، وكان يجد هناك خال والده الشيخ درويش ليدارسه القرآن والعلم، وكان يحثه على دراسة الحساب ومبادئ الهندسة، فكان إذا رجع القاهرة التمس تلك العلوم خارج الجامع الأزهر، ثم صحب الإمام محمد عبده السيد جمال الدين الأفغاني ابتداء من شهر المحرم سنة 1287هـ بعد أن جاء إلى مصر، فتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية. زعم الكثير من مشايخ الأزهر أنَّ تلقي تلك العلوم قد يفضي إلى زعزعة العقائد الصحيحة، فكان إذا رجع الإمام محمد عبده إلى بلده، عرض ذلك على الشيخ درويش فكان يقول له "إن الله هو العليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وإن أعدى أعداء العليم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة، فلا شيء من العلم بممقوت عند الله ولا شيء من الجهل بمجحود لديه إلا ما يسميه بعض الناس علما، وليس في الحقيقة بعلم، كالسحر والشعوذة ونحوهما إذا قصد من تحصيلها الإضرار بالناس". ولقد كان لجمال الدين الأفغاني أثر كبير في شخصية الإمام محمد عبده، وبخاصة في مجال دعوة الإمام إلى التجديد، ثم دخل امتحان العالمية سنة 1294هـ / 1877م ونالها من الدرجة الثانية، ولولا إصرار رئيس لجنة الامتحان الشيخ محمد المهدي العباسي على نجاحه؛ لرسب لأن بعض الأعضاء كانوا قد تواصوا على إسقاطه لآرائه وصحبته لجمال الدين الأفغاني، ثم واصل بعد تخرجه تدريس كتب المنطق، والكلام المشوب بالفلسفة في الأزهر. وفي سنة 1295هـ / 1878م عُيِّن مدرسا للتاريخ بمدرسة دار العلوم، فقرأ على طلابها مقدمة ابن خلدون، وألف لهم كتابًا ضاعت أصوله هو (علم الاجتماع والعمران) وعين مدرسًا للعلوم العربية في مدرستي الألسن والإدارة، ثم اشترك مع أستاذه الأفغاني في التنظيمات السياسية السرية التي أنشأها الأفغاني بمصر، فدخل الحزب الوطني الحر الذي كان شعاره مصر للمصريين -أي لا للأجانب ولا للشراكسة- وكان يضم الطلائع الوطنية المستنيرة من طبقات مصر في ذلك الحين. في سنة 1296هـ / 1879م نُفي الأفغاني من مصر، وعُزل الإمام محمد عبده من مناصب التدريس في مدرستي دار العلوم والألسن، وحُددت إقامته بقرية محلة النصر، وفي سنة 1297هـ / 1880م استصدر رياض باشا ناظر النظار عفوًا من الخديوي توفيق عن الإمام، واستدعاه من قريته وعينه محررًا ثالثًا في الوقائع المصرية ثم رئيسًا لتحريرها وتولى مسؤولية الرقابة على المطبوعات، وفي سنة 1298هـ / 1881م أنشئ المجلس الأعلى للمعارف العمومية، وعين الإمام عضوا فيه. انضم الإمام محمد عبده مع الحزب الوطني الحر إلى الثورة العرابية، وبعد هزيمة الثورة سُجن ثلاثة أشهر، ثم حكم عليه بالنفي إلى بيروت، فأقام الإمام محمد عبده في بيروت نحو عام، ثم دعاه أستاذه جمال الدين الأفغاني إلى باريس، وهناك أنشأ مجلة العروة الوثقى وتعلم اللغة الفرنسية التي أجادها بعد سن الأربعين، واطلع على حضارة أوروبا الحديثة، وبعد توقف العروة الوثقى ويأسه من العمل السياسي المباشر كوسيلة لنهضة الشرق، غادر باريس إلى تونس، ومنها إلى بيروت سنة 1885م على أمل العودة إلى مصر ثانية، وفي بيروت برزت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية فكتب "لائحة إصلاح التعليم العثماني" و "لائحة إصلاح القُطر السوري". اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية سنة 1303هـ / 1886م، ومن الكتب التي شرحها فيها نهج البلاغة وديوان الحماسة وإشارات ابن سينا، وكتاب التهذيب ومجلة الأحكام العدلية العثمانية، كما ألقى فيها دروس التوحيد التي تحولت بعد عودته لمصر إلى رسالة التوحيد، والتي تعد فتحًا جديدًا في هذا العلم؛ حيث أنها تفتح المجال للاجتهاد وتقضي على آثار الجمود. بدأ الإمام محمد عبده تفسير القرآن بمنهج عقلي حديث لم يُسبق في الشرق، وكان ذلك بالمسجد العمري ببيروت، واجتذب درسه الكثير من المفكرين، واستمرت دروسه هذه في التفسير حوالي السنتين، وتزوج في بيروت بزوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى. سعى من بيروت لدى أصدقائه كي يطلبوا له العفو ليعود إلى مصر، وكان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة نازلي هانم فاضل؛ كي تستخدم نفوذها عند اللورد كرومر للعفو عن الإمام، وسعى لذلك أيضًا الشيخ علي الليثي وأحمد مختار باشا، وعندما اقتنع كرومر بأن الإمام لن يعمل بالسياسة، وأنه سيقتصر نشاطه على العمل التربوي والثقافي والفكري؛ استعمل نفوذه في استصدار العفو من الخديوي توفيق؛ فعاد الإمام إلى مصر سنة 1306هـ / 1889م. وبعد عودته إلى مصر؛ أراد أن يمارس عمله المحبب –وهو التدريس- وخاصة في دار العلوم فرفض الخديوي توفيق؛ حتى لا يتيح له فرصة تربية الأجيال الجديدة على أساس من آرائه وأفكاره، فعينه الخديوي قاضيًا بمحكمة بنها كي يبعده عن القاهرة وعن التدريس؛ فقبل على مضض، ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ثم محكمة عابدين ثم ارتقى إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف سنة 1891م. وفي هذه الفترة دارت مراسلات قليلة بينه وبين الأفغاني في الأستانة، بعد أن استقر بها سنة 1892م، ولكن موقف الإمام من السياسة والإنجليز جلب عليه غضب أستاذه؛ حيث اختلف محمد عبده عن جمال الدين الأفغاني؛ في أن محمد عبده كان إصلاحيًا أكثر منه ثوريًا. بعد موت الخديوي توفيق وتولي الخديوي عباس حلمي الثاني السلطنة، قامت فترة من الوفاق بينهما، وكان أساسها أن الإمام أقنع الخديوي بأن يعاونه في العمل لإصلاح المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية الثلاثة: الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، فاصطدمت سياسة الوفاق بينه وبين الخديوي عباس بعاملين أساسيين، الأول وهو مهادنته للإنجليز، والثاني هو رفضه استبدال أراضي الأوقاف التي كان يطمع فيها الخديوي بأراضٍ أخرى. وفي سنة 1310هـ / 1892م اشترك في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، التي تهدف لنشر التعليم وإعانة المنكوبين ثم تولى رئاستها، وفي سنة 1317هـ / 1899م عين في منصب المفتي، وتبعًا لهذا المنصب أصبح عضوًا في مجلس الأوقاف الأعلى؛ فسعى إلى إصلاحها وإصلاح المساجد ثم عين عضوًا في مجلس شورى القوانين. وفي سنة 1318هـ / 1900م أسس جمعية إحياء العلوم العربية، فحققت ونشرت عددًا من آثار التراث العربي الإسلامي الفكرية الهامة، ودرَّس في الأزهر تفسير القرآن الكريم من سنة 1317هـ / 1899م واستمر في إلقاء دروسه نحو ست سنوات؛ أي حتى وفاته، وبلغ في التفسير من أول القرآن حتى الآية 125 من سورة النساء، وكان الشيخ رشيد رضا يُدَوِّن ملخصًا في الدرس لهذا التفسير، وبعد عام من بدئه أخذت تنشره مجلة المنار، وفي سنة 1322هـ / 1905م استقال من مجلس إدارة الأزهر؛ احتجاجًا على مؤامرات الخديوي عباس التي حال بها دون سير الإصلاح.
تعليق
علماء قد تهمك

الزمخشري
ت: 538 هـ | الدولة الخوارزمية

أبو بكر الرازي
ت: 311 هـ | العصر العباسي

الإمام مالك
ت: 179 هـ | العصر الأموي و العصر العباسي

ابن الرزاز الجزري
ت: كان حيًا سنة 602 هـ | الدولة الأرتقية
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد