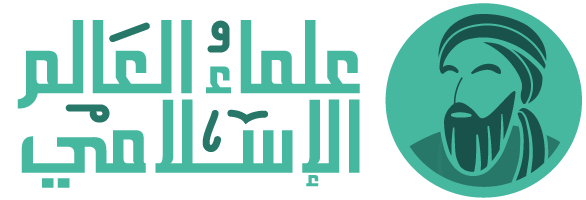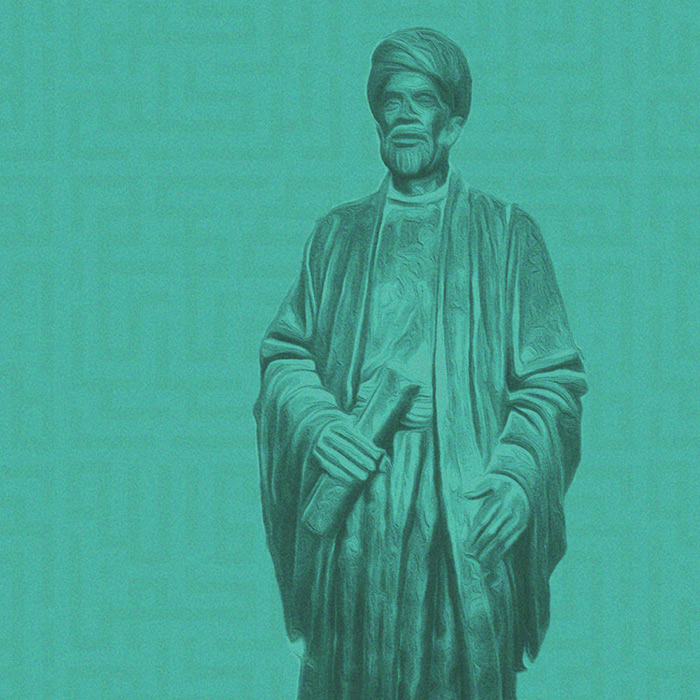
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللَّواتي الطنجي، لُقب بأمير الرحالة المسلمين، وكان مؤرخا وقاضيا، من أعلام القرن 8هـ / 14م، قام برحلات في أماكن كثيرة من العالم المعروف آنذاك، مما مكنه من تأليف كتاب "تُحفة النُّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار". ...السيرة الذاتية
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللَّواتي الطنجي، لُقب بأمير الرحالة المسلمين، وكان مؤرخا وقاضيا، من أعلام القرن 8هـ / 14م، قام برحلات في أماكن كثيرة من العالم المعروف آنذاك، مما مكنه من تأليف كتاب "تُحفة النُّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار". ...السيرة الذاتية
لم يكتبه بنفسه وإنما أملى رحلاته على الكاتب محمد بن جزي الكلبي، فصاغها بأسلوب أدبي.
كتب له كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"
سلطان مراكش وكان ابن بطوطة من حاشيته ومن مقربيه، فنال رعايته عندما استقر في فاس بعد رحلاته الثلاثة
بدأت رحلة ابن بطوطة الأولى في عهد ذلك السلطان قاصدا بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج.
نزل ابن بطوطة في ضيافته ثلاث ليال أثناء وجوده بالإسكندرية.
التقى به بالقدس وأخذ على يديه الطريقة الرفاعية.
سلطان الهند، وقد أحسن استقبال ابن بطوطة وأغدق عليه الأموال عندما دخل الهند.
نزل ابن بطوطة ضيفا عليه عندما وصل إلى الصين.
نشأ ابن بطوطة في أسرة مشهورة بالتدين والإفتاء، وقام بثلاث رحلات واسعة النطاق: الرحلة الأولى (725– 750هـ) / (1325 – 1349م) وتعتبر أهم رحلاته الثلاث وأطولها، وكان الدافع إلى القيام بها هو الحج إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام، بدأت رحلته في عهد السلطان سعيد بن السلطان أبي يوسف بن عبد الحق مخترقًا بلاد الساحل والشمال الإفريقي كله، أقام في تونس فترة يعلم ويفقه ويفتي في جامع الزيتونة، وعندما بدأ الرحلة من تونس طلب إليه الحجيج أن يكون قاضيًا لهم. ولما وصل إلى الإسكندرية في عهد السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون؛ طاف بمعالمها وزار علماءها من بينهم الشيخ برهان الدين الأعرج من كبار الزهاد، وقد نزل في ضيافته ثلاث ليال، بهرت الإسكندرية ابن بطوطة فطاف بالمدينة، ورأى أبواب سورها الأربعة ومنارتها الشهيرة وعمود السواري، وسعى للقاء الأولياء بالمدينة لينال بركاتهم وكان بينهم الزاهد خليفة. ثم انفصل عن ركب الحجاج التونسي وسافر إلى القاهرة، فزار جامع عمرو بن العاص ومساجد الحسين والسيدة زينب والإمام الشافعي، ورأى الأهرامات، ووصف المدارس والبيمارستانات وزوايا المتصوفة الفقراء، ووصف النيل، وذكر سلطان مصر وبعض أمرائها آنذاك، وذكر العديد من قضاة مصر حين دخلها، كما أنه أفاض الحديث عن كرامات أبي الحسن الشاذلي. غادر ابن بطوطة القاهرة إلى الصعيد في طريقه إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر؛ كي يبحر منه إلى جدة على الشاطئ المقابل، وعبر ابن بطوطة النيل وسار إلى مُنية الخصيب (المنيا الآن)، ورأى في (ملَّوي) إحدى عشرة معصرة لقصب السكر، ورأى بمنفلوط أضخم منبر شاهدته عيناه، وجالس علماء قوص، وزار في الأقصر مسجد العابد أبي الحجاج الأقصري، ثم عبر ابن بطوطة عند إدفو إلى قرية العطواني حتى وصل إلى عيذاب، ولكنه عاد إلى صعيد مصر -ولم يحج في ذلك العام- وركب من إدفو مركبًا سارت به في النيل إلى القاهرة، ثم سافر إلى سيناء مارًّا ببلبيس والصالحية في طريق الشام. رحل ابن بطوطة إلى بيت المقدس فوصفها، ووصف المسجد الأقصى، ووصف قبة الصخرة، كما ذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف، وذكر أيضًا بعض فضلاء القدس الذين التقى بهم، وأخذ الطريقة الرفاعية على يد الشيخ "عبد الرحيم الرفاعي" وارتدى ثياب التصوف، ثم تجول بعد ذلك في أرض فلسطين، وقد خرب الكثير من بلادها، فمسجد عمر في عسقلان لم يبق منه سوى جدرانه، وعكا قد خُرِّبت وخُرِّب سورها، وزار قبر أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح في الأردن، ثم في طبرية قام بزيارة الجُب الذي يقال إنه هو الجُب الذي ألقى فيه إخوة يوسف به، وكان جبًّا كبيرًا عميقًا تتجمع فيه مياه الأمطار. وواصل ابن بطوطة رحلته مع الساحل إلى لبنان؛ فرأى مدينة صُور التي يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وصيدا وبيروت، وشَرَّق ابن بطوطة فزار حمص وحماة الشهيرة بنواعيرها (سواقيها)، ومعرَّة النعمان، وزار بها قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز، وزار سرمين الشهيرة بصناعة الصابون من زيت الزيتون، وقد أخذ الغرب هذه الصناعة من العرب، وعَجِبَ ابن بطوطة من أهل (سِرمين)؛ حيث كان أهلها كثيري السباب عاليِي الأصوات، وكانوا يتشاءمون برقم عشرة، وإذا عدوا نقودًا وبلغوا الرقم تسعة، قالوا: تسعة وواحد، تسعة واثنان.. وهكذا. ورأى قلعة (حلب) وتجول بين بساتينها، وسمع ما قيل فيها من أشعار، ثم اتجه غربًا إلى (أنطاكية) التي استردها الظاهر بيبرس يومًا من الصليبيين، وبات فيها في زاوية (حبيب النجار) ورأى بها شيخ الزاوية، وزار بالقرب من أنطاكية حصون الإسماعيلية الفِداوية، ودخل ابن بطوطة دمشق في اليوم التاسع من شهر رمضان، وقد مضى على خروجه من طنجة أكثر من عام، وكان ما معه من مال قد قارب على النفاذ؛ فظل ابن بطوطة مقيمًا عند نور الدين السخاوي إمام المالكية بالجامع الأموي إلى يوم العيد، ثم اتجه بعد ذلك إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. قام ابن بطوطة أثناء أداء فريضة الحج بوصف مكة والمسجد الحرام والكعبة، وكانت هذه هي حَجته الأولى، ثم سافر من مكة إلى العراق، ثم بلاد فارس والأناضول، ثم عاد إلى مكة مرة أخرى ليحج مرة ثانية، وبقي ابن بطوطة بعد الحج مجاورًا الكعبة شهورًا، وكان ينزل ضيفًا بالمدرسة المُظَفرية وينعم بطيب العيش وبالتفرغ للعبادة والطواف ولقاء المجاورين للكعبة، ثم غادر ابن بطوطة من مكة إلى اليمن في سفينة، وهبَّت عاصفة بحرية حملت السفينة بعيدًا عن اليمن إلى (رأس الدوائر) بين مينائي عيذاب وسواكن. ركب البحر من سواكن في سفينة أخرى حملته إلى اليمن، وكانت في حُكم (بني رسول)، وزار مدن: حلي وزبيد وتعز وصنعاء، ثم ارتحل إلى عدن، ثم أبحر من عدن إلى زيلع في (جيبوتي الآن) ثم ركب البحر إلى مقديشيو (بالصومال الآن) فاستقبله الناس مرحبين، وصحبه القاضي لزيارة السلطان فأنزله ضيفًا بدار الطلبة، ثم واصل رحلته إلى مُمبسة (منبسى الآن) بأرض كينيا ثم واصل رحلته إلى (زنجبار) وإلى (كِلوة) كلاهما بتنزانيا الآن. ثم عاد إلى ظَفار ثم عُمَان والبحرين، واتجه بعد ذلك إلى مكة ليحج مرة ثالثة، ثم سافر بعد الحج إلى آسيا الصغرى (تركيا الآن) وكان يصحبه في رحلته صديقه القاضي عبد الله التوزري التونسي، وظلَّا متلازمين عددا من السنين لم يفترقا إلا بعد خروجه من بلاد الهند. وبعد ذلك توجه إلى بلاد الهند عابرًا بُخارى وخوارزم وخراسان وتركستان وأفغانستان وكابول والسند، ثم دخل دلهي، وقد أحسن السلطان محمد تُغلُق استقبال ابن بطوطة، وأغدق عليه الأموال هو وصاحبه التوزري، وعينه قاضيًا لدار الملك، ومشرفًا على ثلاثين قرية، له العشر من خراجها، فكان نصيبه كل عام أربعة وعشرين ألف دينار. ثم جاء رسل من ملك الصين محملين بالهدايا للسلطان، وطلب وفد الملك من السلطان أن يأذن للبوذيين في (سمهل) بإعادة بناء معبد بوذي، كان المسلمون قد هدموه في غابر السنين، وكان الصينيون يحجون إليه قبل دخول الإسلام إلى الهند، فاعتذر السلطان عن الموافقة على هذا الطلب، ورأى أن يطيب خاطره بأن يبعث إليه بهدية يحملها إليه وفد من قِبله، وطلب السلطان من ابن بطوطة أن يكون رسولًا عنه إلى ملك الصين، فخرج ابن بطوطة بالفعل في وفدٍ مُحمَّلٍ بالهدايا، إلا أن هذا الوفد واجه قطاع طرق؛ فهرب ابن بطوطة إلى أن استطاع أن يتجمع مع الوفد مرة أخرى في ميناء قندهار. ولما بلغ ابن بطوطة ميناء قاليقوط هبَّت عاصفة كبيرة؛ نزعت مراسي السفن الكبيرة، وحملتها بعيدًا عن الشاطئ، فغرقت هدايا السلطان، وراح ابن بطوطة يجوب مدن الشاطئ عبثًا، ينتظر العثور على سفينته أو معرفة أخبار عنها، وحين يئس ذهب بحرًا إلى (هنور) فأكرمه أميرها جمال الدين، ونصحه بعدم العودة إلى دلهي حتى لا يعاقبه السلطان لتخليه عن الهدية، وكان هذا الأمير يعد أسطولًا بحريًا لفتح سندابور، وانضم ابن بطوطة إلى الحملة وقاتل بشجاعة مع الأمير حتى تحقق النصر وفتحت المدينة؛ فأكرمه الأمير، ثم أبحر في مركب عن سندابور إلى جزر ذيبة المهل (المالديف الآن) جنوب غرب الهند، وكان يَدينُ أهلها بالإسلام، ثم تولى القضاء في جزر ذيبة المهل إلا أنه لم يوفق؛ نظرًا لاختلاف عادات أهل هذه الجزر فلم يكن حكيمًا في التعامل معهم. رحل ابن بطوطة وأخذ يتجول بين الجزر متجهًا إلى جزيرة سرنديب (سيلان الآن) ولقي ملكها، ثم عبر البحر في مضيق (بلك) إلى ساحل (كروماندول) شرقي الهند، ثم توغل بعد ذلك في بلاد كثيرة حتى وصل إلى جبال (كامرو) كامروب الآن، وكانت الجبال تتصل بالصين الشمالي شرقًا وبلاد التِّبِت جنوبًا، وقابل بها الولي (جلال الدين التبريزي) وواصل سيره إلى مدينة (سدكاوان) سوناجاون الآن، ثم أبحر إلى شبه جزيرة ملقا في بلاد الملايو، فاستقبله سلطان الجزيرة بترحاب. أبحر ابن بطوطة بعد ذلك إلى الصين، فنزل ضيفًا على القاضي (تاج الدين الأردويلي) وقابل بها السفير الصيني الذي كان ملك الصين قد أوفده إلى الهند، فمهد هذا له الطريق للقاء الخان الكبير ملك المغول والصين في مدينة (خان بالق) بكين الآن، إلا أنه لم يستطع مقابلته نتيجة الاضطرابات التي كانت سائدة وقتئذ، مما دفعه إلى مغادرة الصين الشمالي إلى الصين الجنوبي. ثم ركب البحر بعد ذلك إلى بلاد عُمان فوصل إليها بعد ثمانية وعشرين يومًا، وغادرها بحرًا إلى غربي إيران، فالعراق فالشام ومصر، ثم قرر بعد ذلك أن يؤدي فريضة الحج عن طريق ميناء عيذاب، وكانت تلك حجته الرابعة، وبعد ذلك قرر أن يعود إلى وطنه فمرَّ بمصر وتونس والجزائر ومراكش، حتى وصل إلى فاس المغربية، فشملته رعاية السلطان أبي عنان المريني وكان قريبًا منه، واستقر هناك نحو عامين عالمًا ومستشارًا له. أما الرحلة الثانية: فلم يُقم ابن بطوطة في فاس طويلًا حتى وجد في نفسه نزوعًا إلى السفر إلى بلاد الأندلس، فمرَّ في طريقه بسبتة وطنجة وجبل طارق ومالقة وغرناطة، ثم عاد بحرًا إلى أصيلا بالمغرب، ولقي السلطان أبا عنان بمراكش، وعاد معه إلى العاصمة فاس. وكانت رحلته الثالثة: من عام (753 – 755هـ / 1352 – 1354م) وكانت نحو أفريقيا، زار خلالها بعض المناطق، ثم رجع إلى فاس، ويعد ابن بطوطة أول سائح كتب عن أفريقيا الوسطى، وفي عام 1355م عاد إلى مراكش بعد أن قضى قرابة ثلاثين عامًا في رحلات مستمرة، زار خلالها 44 قُطرًا من دول عالمنا المعاصر، وقطع في رحلاته مسافة تصل إلى 73000 ميل؛ أي ما يقارب 117500 كيلومتر. أقام ابن بطوطة في حاشية السلطان أبي عنان المريني؛ محدثًا للناس بما رآه من عجائب الأسفار، ولما علم السلطان بأمره وما ينقله من طرائف الأخبار عن البلاد التي زارها؛ أمر كاتبه الأديب أبا عبد الله محمد بن جزي الكلبي أن يكتب ما يمليه عليه ابن بطوطة، فانتهى من كتابتها سنة (756هـ / 1356م)، وسماها: تُحفة النُّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، فصاغها بأسلوب أدبي جمع بين حيوية العرض ودقة الوصف. واستغرقت عملية تدوين الكتاب عامين كاملين، فشرح ابنُ جزي في مقدمته؛ أن العمل الذي كلف السلطان ابن بطوطة القيام به؛ هو أن يقوم بإملاء بيانات عن المدن التي رآها في رحلاته والأشياء ذات القيمة التي علقت بذاكرته، وأن يذكر طرفا عن الحكام الذين رآهم في الأقطار التي زارها، وعن العلماء والشيوخ الذين التقى بهم. وتمثل الرحلة مسحًا شاملًا للعالم الإسلامي، خلال الربع الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، ويتضمن في هذا المسح: الشخصيات والأماكن وأساليب الحكم والعادات والغرائب والعجائب، وعُرفت تلك الرحلة في العالم الغربي لأول مرة في القرن التاسع عشر الميلادي، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصدرًا تتكرر الإشارة إليه في كثير من المؤلفات التاريخية، باعتبارها رواية لشاهد رؤية وحيد لأماكن كثيرة في تلك الفترة. وكانت بداية عهد ابن بطوطة بالرحلات ومغادرته لأرض وطنه، قد حدثت بينما لم يمض على وفاة ماركو بولو سوى عام واحد، وجاء كتاب ابن بطوطة في مستوى لا يقل أهمية عما سُطر في كتاب ماركو بولو. طُبعت رحلة ابن بطوطة في باريس مع ترجمة فرنسية على يد المستشرق ديفريمري Defremery وسانجنتي Sanguinetti، وطبعت في القاهرة طبعتان عربيتان، ونشر الأستاذ جب Gibb ملخصًا لها بالإنجليزية سنة 1929م، وكان ابن بطوطة يحدِّث الناس بما رأى من عجيب صنع الله في خلق الحيوان والنبات، وما شاهده من أخلاق الأمم وعاداتهم وأحوالهم. توجد بعض الشكوك عن صحة رحلة ابن بطوطة إلى بعض الأماكن؛ منها أراضي المسلمين البلغار على نهر الفولجا، وأجزاء من الصين وبيزنطة وخراسان واليمن والأناضول وشرق أفريقية، ولعل بعض الاضطراب في أخبار ابن بطوطة يرجع إلى أنه لم يدون رحلته بنفسه، وأن ابن جزي عدَّ في بعض أخبارها وغيَّر فيها بالحذف أو الإضافة، بعد أن راجع طائفة من كتب الأسفار الأخرى، حتى جاءت بعض الأخبار بعيدة عن الدقة، ولا سيما أحاديث ابن بطوطة عن الصين. وجدت بعض الإشارات العلمية في رحلة ابن بطوطة، منها اهتمامه بالثروات المعدنية، فزار مغاص اللؤلؤ (مغاص هو المكان الذي يستخرج منه اللؤلؤ) ومنابع النفط، ويقول ابن بطوطة في أثناء حديثه عن حمامات بغداد "وحمامات بغداد كثيرة، وهي من أبدع الحمامات، وأكثرها مطلية بالقار، مسطحة به، فيخيل لرائيه أنه رخام أسود، وهذا القار يجلب من عين بين الكوفة والبصرة"، وعند وصفه لجزيرة سيلان يذكر الياقوت المنتشر فيها، ويذكر أن منه الأحمر والأصفر والأزرق ويسمونه "التيلم". ومن الأمور التي أولاها اهتمامه المناظر الطبيعية؛ ولذلك تكلم عن فيضانات الأنهار واتجاهات الرياح، كما تحدث عن السهول والجبال والهضاب والتضاريس المختلفة؛ فحين يتحدث عن نهر النيل مثلًا يذكر أن مجراه من الجنوب إلى الشمال، خلافًا لجميع الأنهار الموجودة في العالم القديم، ويذكر ابن بطوطة من عجائب النيل: "إن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفوفها، وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفيضها، ونهر السند مثله في ذلك". وعن نظام التدريس العلمي في الجامعة المستنصرية بمدينة السلام (بغداد) يقول ابن بطوطة "كان المدرس يجلس في قبة خشب صغيرة على كرسي عليه البسط، وعليه –أي الأستاذ- السكينة والوقار، لابسًا ثياب السواد معتمًا، وعلى يمينه ويساره معيدان يعيدان كل ما يمليه الأستاذ". وهنا لابد من الإشارة إلى أن لقب المعيد ظل ساريًا في النظام الجامعي في بعض البلدان العربية حتى الآن، وكذلك العباءة السوداء التي يرتديها أساتذة الكليات، أثناء مناقشات الرسائل العلمية في الجامعات، ما تزال مستعملة إلى يومنا هذا. يقول ابن بطوطة عن فن التصوير في بلاد الصين "ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك، أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها، إلا وَجدتُ صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق، ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشين، ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زي العراقيين، فلما عدت من القصر عشيًّا، مررت بالسوق المذكورة، فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط، ويُعَقِّب ابن بطوطة على ذلك بالقول "وتلك عادة لهم في تصوير كل من يمر بهم، إلا أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم، بعثوا بصورته إلى البلاد، وبُحث عنه، فحينما وُجد شبه تلك الصورة أُخذ". وتمير ابن بطوطة بالكثير من الصفات الحميدة؛ منها أنه كان رقيق المشاعر، سريع التأثر، ويتضح ذلك من أنه حين ترك والديه تأثر لفراقهما تأثرًا كبيرًا، كما أنه عندما وصل مدينة تونس وبرز أهلها للقاء بعض كبار الشخصيات في القافلة التي لحق بها، وأقبل بعضهم على بعض بالسلام والسؤال، ولم يسلم عليه أحد لعدم معرفتهم به وجد من ذلك في النفس ألما واشتد بكاؤه؛ حتى شعر بحاله بعض الحجاج؛ فأقبلوا عليه بالسلام والإيناس. ولما عاد من رحلته الأولى وعلم أن والدته قد ماتت حزن لذلك حزنًا شديدًا، وانقطع عن كل شيء وسارع إلى زيارة قبرها في طنجة، وكان وقع المصيبة شديدًا على نفسه؛ فمرض ثلاثة أشهر قضاها في سبتة. كان ابن بطوطة رجلًا مسلمًا تقيًّا، مالكي المذهب مثل أهل المغرب العربي، معظمًا للصالحين، يزور قبورهم ويتبرك بهم، ويروي كثيرًا عن كراماتهم، وما ينسب إليهم من أعمال البر، اعتقد في صحة الكرامات التي حكيت له أو التي حدثت له هو نفسه، مثل كرامة الشيخ خليفة السكندري، وكرامة أبي الحسن الشاذلي الذي أخبره بها ياقوت الحبشي المتصوف السكندري...إلخ. بعد الرحلة الثالثة؛ وضع ابن بطوطة عصا الترحال، ومضى بقية عمره حتى عام 779هـ حاملًا مسئولية القضاء في (تامسنا)، ويروي على الناس أخبار الناس من غانة إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا، وتوجد في نابلس بفلسطين الآن أسرة تدعى (بيت بطبوط) وتعرف ببيت المغربي وبيت كمال، تقول إنها من نسل ابن بطوطة.
تعليق
علماء قد تهمك

ثابت بن قرة
ت: 288 هـ | عربي الأصل | العصر العباسي

ياقوت الحموي
ت: 626 هـ | رومي الأصل | العصر العباسي

ابن يونس المصري
ت: 399 هـ | الدولة الفاطمية

ذو النون المصري
ت: 245 هـ | عربي الأصل | عصر الولاة بمصر
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد