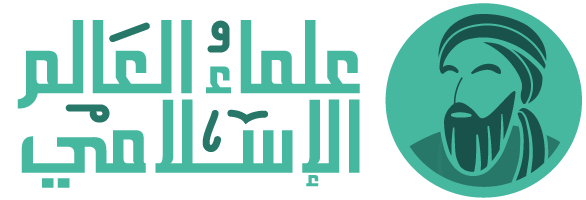رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي، رائد النهضة العلمية الحديثة في عصر أسرة محمد علي، تخصص في ترجمة العلوم العصرية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ...السيرة الذاتية
رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي، رائد النهضة العلمية الحديثة في عصر أسرة محمد علي، تخصص في ترجمة العلوم العصرية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ...السيرة الذاتية
ويسمى الديوان النفيس بإيوان باريس. تحدث فيه عن أسباب الرحلة وما رآه منذ فارق وطنه إلى أن وصل إلى باريس وما شاهده في تلك المدينة من عادات أهلها ونظمهم وحضارتهم ثم وصف عودته إلى أرض الوطن، وقد أضاف فصولًا بعد عودته إلى مصر. قدم هذا الكتاب إلى أستاذه الشيخ حسن العطار الذي أشار عليه قبل رحيله إلى فرنسا أن يدون رحلته في تلك الأقطار فأثنى عليه أما محمد علي فطلبه وأمر أن يقرأ له فحاز رضاه وأمر بأن يترجم إلى اللغة التركية وأن تطبع النسختان العربية والتركية في مطابع الحكومة وعلى نفقتها. طبع الكتاب في حياته طبعتين الأولى سنة 1834م، والثانية 1849م، والتي يرى البعض أنها السبب في نفيه، كما طبع بعد وفاته طبعة ثالثة، وذلك عام 1905م، وقد طبع بعد ذلك كثيرًا سواء ضمن الأعمال الكاملة التي جمعها وحققها وعلق عليها الدكتور محمد عمارة وصدرت عن المؤسسة العربية للنشر عام 1973م، أو طبع بشكل منفصل مثل طبعة دار الهلال عام 2001م.
وهو الذي خصصه لمعالجة مسائل التمدن والعمران، وقد طبع في حياته وذلك عام 1869م، كما طبع مرة ثانية بعد وفاته 1912م، وكذلك طبع ضمن الأعمال الكاملة، ونشر المجلس الأعلى للثقافة طبعته الثانية بتقديم حلمي النمنم، ودراسة مصطفى عبد الغني، وذلك عام 2002م.
وهو الجزء الأول من موسوعة التاريخ التي كان الطهطاوي قد عزم على تأليفها، ويضم هذا الجزء تاريخ مصر القديم حتى الفتح الإسلامي، وتاريخ العرب حتى إرهاصات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع في حياته وذلك سنة 1868م.
وهو الجزء الثاني من موسوعة التاريخ التي شرع في تأليفها، وقد خصص هذا الجزء لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقومات البناء السياسي والإداري والقضائي للدولة الإسلامية الأولى، وهو آخر كتاب ألفه الطهطاوي وكان قد شرع في نشره بملاحق روضة المدارس ثم أعاد نشره في صورة كتاب.
خصصه لفكره في التربية وآرائه في الوطنية والتمدن، وطبع في العام الذي توفى فيه، وذلك عام 1873م.
رسالة في قواعد اللغة العربية روعي فيها التبسيط، طبع في حياته عام 1869م.
من أبرز شيوخ رفاعة الطهطاوي، وتأثر الشيخ حسن العطار بالعلوم والحضارة التي تمتعت بها فرنسا أثناء اتصاله بهم أبان الحملة الفرنسية على مصر، مما كان له أثر على تلميذه رفاعة الطهطاوي في الاهتمام بتلك العلوم.
أشرف على البعثة، وكان من علماء الحملة الفرنسية، وأصبح بعد ذلك رئيسًا للجمعية الجغرافية، وعضوًا في المعهد الفرنسي شجعه على دراسة اللغة الفرنسية ووجهه إلى الاهتمام بالترجمة، وعمل على رعايته حتى إنه كان يقدم له الهدايا لحثه على الدراسة وزيادة الاطلاع، ومن هداياه: كتاب يسمى رحلة إنخرسيس في بلاد اليونان لاجتيازه الامتحان الأول، ويتكون من سبعة مجلدات جيدة التجليد مموهة بالذهب، كما أهداه لاجتيازه الامتحان الثاني كتابين وهما: الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وجامع الشذور من منظوم ومنثور تأليف مسيو دساسي.
أشاد به كثيرًا خصوصًا في تقريره النهائي عنه.
نشأت بين رفاعة الطهطاوي وبين سلفستر دي ساسي صداقة متينة.
نشأت بين رفاعة الطهطاوي وبين كوسان دي برسيفال صداقة متينة.
من أبرز تلاميذ رفاعة الطهطاوي
تلقى رفاعة الطهطاوي تعليمه الأولي في مدينة طهطا، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة سنة 1232هـ / 1817م، والتحق بالأزهر الشريف الذي مكث فيه خمس سنوات ختم فيها دروسه، ثم اشتغل بعد ذلك بالتدريس في الجامع الأزهر، ودرَّس كتبًا شتى في الحديث والمنطق والبيان والبديع والعروض وغير ذلك. وكان يحضر دروسه جمهور كبير من الطلبة، فقضى بالأزهر عامين يقوم بالتدريس، وكان في نفس الوقت يتردد على مدينته طهطا، ويلقي بعض الدروس بجامع جده أبي القاسم، وامتازت دروسه بجاذبية كانت تحببه إلى المستمعين وترغبهم في الاستفادة منه، وكان رفاعة الطهطاوي من أقرب تلاميذ الشيخ حسن العطار، وحينما طلب محمد علي من الشيخ العطار أن يختار له إمامًا لإحدى فرق الجيش؛ رشح له الطهطاوي لهذا المنصب، وعُيَّن سنة 1239هـ / 1824م واعظًا وإمامًا في آلاي حسن بك المناسترلي ثم انتقل إلى آلاي أحمد بك المنكلي. وفي سنة 1241هـ / 1826م أُوفِدت أول بعثة كبيرة إلى فرنسا، وكان رفاعة إمامًا لها بترشيح أيضًا من الشيخ حسن العطار، وقضى تلاميذ البعثة جميعًا نحو سنة في بيت واحد، فيقول رفاعة عن هذه الفترة "كنا نقرأ في الصباح كتاب تاريخ ساعتين، ثم بعد الظهر درس رسم ثم درس نحو فرنساوي، وفي كل جمعةٍ ثلاثةُ دروس من علمي الحساب والهندسة". وكانت هذه الخطة ترمي إلى عزل تلاميذ البعثة؛ حتى لا يفسدهم الاختلاط في باريس، ولكن هذه العلوم التي أُوفِدوا لدراستها مودعةٌ في بطون المؤلفات الفرنسية، ولا سبيل إليها إلا بإتقان هذه اللغة قراءة وكتابة وحديثًا وفهمًا، ولا سبيل إلى هذا الإتقان إلا أنْ يختلط هؤلاء الشبان بأندادهم من الفرنسيين حتى تستقيم ألسنتهم؛ فتم توزيع طلاب البعثة بعد ذلك ليختلطوا بالفرنسيين؛ حتى يتعلموا اللغة بشكل أفضل. قرأ رفاعة كتبًا كثيرة في مختلف العلوم مع أساتذته وبمفرده، حتى تكونت له ثقافة موسوعية، وكان حريصًا على ترجمة أجزاء كثيرة منها، وقضى رفاعة سنةً في باريس، ثم عقد له ولزملائه امتحان في نهاية هذه السنة فنجح رفاعة بتفوق، وأرسل إليه مسيو جومار مدير البعثة جائزة التفوق، وهي كتاب (رحلة أنخرسيس في بلاد اليونان) وهو سبعة مجلدات جيدة التجليد مُمَوهة بالذهب، وبعد عام آخر عُقد امتحان ثانٍ فوفق فيه كما وفق في سابقه، وكانت جائزته هذه المرة كتابين من تأليف المستشرق الفرنسي دي ساسي، وهما: الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وجامع الشذور من منظوم ومنثور. وفي باريس اتصل الشيخ رفاعة بكبار المستشرقين الفرنسيين، وخاصة المسيو سلفستر دي ساسي، والمسيو كوسان دي برسيفال، ونشأت بينه وبين هذين العالمين صداقة متينة، وبعد خمس سنوات عقد لرفاعة الامتحان النهائي، فجمع المسيو جومار مجلسا فيه عدة أناس مشاهير، يقول عنه رفاعة "وكان القصد بهذا المجلس معرفة قوة الفقير في صناعة الترجمة التي اشتغلتُ بها مدة مُكثي في فرنسا". تقدم رفاعة إلى لجنة الامتحان بخلاصة مجهوداته في الترجمة طوال هذه السنوات الخمس، وهي اثنتا عشرة رسالة ترجمها عن الفرنسية إلى العربية، كذلك قدم رفاعة للجنة الامتحان كراسة أخرى فيها مخطوطة رحلته إلى باريس، وذلك لأن هذه الرحلة ليست تأليفًا كلها، بل فيها نبذ كثيرة مترجمة في مختلف العلوم قصد بها رفاعة إلى تقريب هذه العلوم إلى القارئ المصري، وشرح نهضة الفرنسيين العلمية ومدى إقبالهم على الدروس والتحصيل، وترجم فيها أيضًا الدستور الفرنسي الذي وضعه لويس الثامن عشر، وفيها أيضًا ترجم بعض الأشعار الفرنسية إلى الشعر العربي، واختبرته اللجنة بالإضافة إلى ذلك اختبارًا شفهيًا؛ فاجتاز رفاعة الامتحان بتفوق، وعاد إلى مصر سنة 1247هـ / 1831م، ويصفه علي مبارك بقوله "ولم تؤثر إقامته بباريز أدنى تأثير في عقائده ولا في أخلاقه وعوائده". وفي ميناء الإسكندرية قابله إبراهيم باشا فرحب به ومنحه ستة وثلاثين فدانًا من المزرعة الملكية، وكانت أول مكافأة مادية نالها الطهطاوي على جده واجتهاده، ثم سافر الطهطاوي إلى القاهرة فحظي بمقابلة محمد علي، وكان قد عرفه من تقارير البعثة عنه، وكلها مدح وثناء عليه، فتم تعيينه مترجمًا بمدرسة الطب، فكان أول مصري يُعيَّن مترجمًا بهذه المدرسة؛ إذ كانت هيئة المترجمين جميعًا من السوريين. لبث رفاعة في مدرسة الطب سنتين كان فيهما مصححًا ومحررًا، أكثر منه مترجمًا ثم نقل إلى مدرسة الطوبجية (المدفعجية) بطرة سنة1249هـ / 1833م خلفًا للمستشرق Koening وفيها قام بترجمة الكتب الهندسية والجغرافية اللازمة لهذه المدرسة، وفي سنة 1250هـ / 1834م ظهر في مصر مرض الطاعون، وانتشر في القاهرة وكثير من البلدان الأخرى، فطلب رفاعة إجازة وسافر إلى بلده طهطا، ولبث هناك نحو ستة أشهر زار خلالها الأهل والأقارب، وحمل معه الجزء الأول من جغرافية Malte Brun، وكان قد بدأ فترجم منه صفحات وهو في باريس فأكمل ترجمة الجزء الأول كله. أُنشئت مدرسة الألسن سنة 1252هـ / 1836م باسم مدرسة الترجمة، ثم غُيَّر اسمها فأصبح مدرسة الألسن، وجُعل مقرها السراي المعروفة ببيت الدفتردار بحي الأزبكية حيث فندق شبرد الآن، وقد أنشئت هذه المدرسة تحقيقًا لاقتراح تقدم به رفاعة لمحمد علي باشا، وقد ظل رفاعة نحو ستة عشر عامًا ناظرًا للألسن، ومدرسًا بها ومديرًا لها ومشرفًا على قلم الترجمة، ومصححًا لجميع الكتب التي ترجمها تلاميذه، وفي سنة 1257هـ / 1841م علاوةً على نظارة مدرسة الألسن أُحيل إليه تولي نظارة المدرسة التجهيزية، ومعهد للفقه والشريعة الإسلامية ومدرسة محاسبة ومدرسة إدارة إفرنجية، وأحيل إليه تفتيش مدارس الأقاليم. ثم أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة الوقائع المصرية التي أسسها محمد علي عام 1243هـ / 1828م، وظل الطهطاوي ناظرا لمدرسة الألسن، إلى أن أُقفلت في عهد عباس باشا الأول سنة 1267هـ / 1851م، ولم يكتف بإقفالها بل أمر بإرسال رفاعة الطهطاوي إلى السودان أي نفيه؛ بحجة توليه نظارة مدرسة ابتدائية أمر بإنشائها في الخرطوم، التي مكث فيها نحو ثلاث سنوات قاسى فيها الأمَرَّيْن؛ لا كرهًا في السودان ولكن لشعوره أنه مَنفي، ومع ذلك قام بواجبه في مدرسة الخرطوم خير قيام. وفي سنة 1270هـ / 1854م تولى سعيد باشا عرش مصر؛ فعاد الطهطاوي إلى مصر ومعه رفاقه الذين تم نفيهم معه، فقربه سعيد باشا إليه، وأسند إليه المناصب المختلفة، فتولى الطهطاوي نظارة القلم الإفرنجي بالقاهرة، ثم عَهِد إليه سعيد باشا سنة 1271هـ / 1855م وكالة المدرسة الحربية بالحوض المرصود، ثم تولى نظارة المدرسة الحربية التي أنشأها سعيد باشا بالقلعة، وجمع بين هذه المناصب ونظارة قلم الترجمة ومدرسة المحاسبة والهندسة الملكية ومدرسة العمارة. كان الطهطاوي يرجو أن يوفق في عهد سعيد باشا بأن يعيد مدرسة الألسن، ولكنه استطاع بعد أن عُين ناظرًا للمدرسة الحربية أن يجعل فيها دراسة اللغة العربية واجبة على الجميع، وترك للتلاميذ حرية اختيار إحدى اللغتين الشرقيتين (الفارسية أو التركية) وإحدى اللغات الأوروبية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية)، ولم يلبث بعد هذه الخطوات أن أنشأ بالمدرسة الحربية فرقة خاصة بالمحاسبة ثم ألحق بها قلمًا للترجمة. سعى أيضا رفاعة الطهطاوي إلى إحياء المؤلفات القديمة ونشرها، حتى حصل على الموافقة بطبع جملة كتب عربية على نفقة الحكومة، منها تفسير الرازي وخزانة الأدب ومقامات الحريري وغيرها من الكتب التي كانت عديمة الوجود في ذلك الوقت، وفي سنة 1276هـ / 1860م أُلغيت المدارس التي كان يشرف عليها الطهطاوي كما ألغي قلم الترجمة، فبقي رفاعة الطهطاوي بغير منصب إلى عهد إسماعيل باشا الذي باشر الاهتمام بالتعليم مرة أخرى. وفي عهد إسماعيل باشا أُعيد قلم الترجمة بوزارة المعارف العمومية، وعهد إلى رفاعة برئاسته سنة 1280هـ / 1863م، وعُين عضوا في قومسيون المدراس، وكان دور قومسيون المدارس النظر في السياسة العليا للتعليم، وقد لاحظ رفاعة الطهطاوي أنَّ الكتب التي بين أيدي التلاميذ غير صالحة؛ فبدأ يضع بنفسه كتبًا جديدة وكانت تلك الخطوة هي الأولى في سبيل النهضة بالكتب المدرسية. كما أنه أول من نادى بتعليم المرأة في مصر بل في الشرق كله، وذلك منذ عهد محمد علي باشا، إلا أن المجتمع وقتئذ لم يكن مهيئا لقبول الفكرة، وفي عام1290هـ / 1873م أنشئت أول مدرسة لتعليم البنات في مصر، حيث أنشأتها الأميرة عفت هانم الزوجة الثالثة للخديوي إسماعيل، وقبل إنشاء المدرسة بسنةٍ واحدة أخرج رفاعة كتابه "المرشد الأمين للبنات والبنين" وفيه يدعو للفكرة ويمهد لظهورها، ثم فتح الخديوي إسماعيل في العام التالي 1291هـ / 1874م مدرسةً مماثلةً للبنات في حي الغربية. وقد فكَّر علي باشا مبارك في إصدار مجلة علمية؛ تكتب فيها الأبحاث باللغة العربية، ولم يلبث أن أخرج فكرته إلى حيز التنفيذ، وعهد برئاسة تحرير المجلة إلى رفاعة بك، يعاونه ابنه علي بك فهمي رفاعة مدرس الإنشاء بمدرسة الإدارة والألسن وقتذاك، وسميت هذه المجلة بروضة المدارس، وقد صدر العدد الأول منها سنة 1278هـ / 1870م أي قبل وفاة رفاعة بثلاث سنوات، وظل رفاعة يتولى رئاسة تحرير الروضة إلى أن مات، فتولاها من بعده ابنه علي بك فهمي. وصف صالح مجدي بك أستاذه رفاعة بأنه كان "قصير القامة، عظيمًا، واسع الجبين، متناسب الأعضاء، أسمر اللون، ثابت السكون، وكان فيه دهاء وحزم، وجرأة وثبات وعزم، وإقدام ورياسة، ووقوف تام على أحوال السياسة، وتفرُّس في الأمور، وكان حميد السيرة، حسن السريرة". كان رفاعة كثير الشعر في مدح محمد علي؛ لما رآه من جهوده التي بذلها لإحياء مصر والنهضة بها حربيًا وثقافيًا واقتصاديًّا، وكان محمد علي باشا دائم الإنعام على رفاعة، وقد أنعم عليه بمائتين وخمسين فدانًا، وأقطعه إبراهيم باشا حديقةً نادرة المثال تبلغ ستة وثلاثين فدانًا، وأنعم عليه سعيد باشا بمائتي فدان، وإسماعيل باشا بمائتين وخمسين فدانًا.
تعليق
علماء قد تهمك

ابن آجروم
ت: 723 هـ | عربي الأصل | الدولة المرينية

ابن سينا
ت: 428 هـ | الدولة السامانية و الدولة الغزنوية

بختيشوع بن جبرئيل
ت: 256 هـ | سرياني الأصل | العصر العباسي

الأزرقي
ت: 244 هـ | عربي الأصل | العصر العباسي
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد