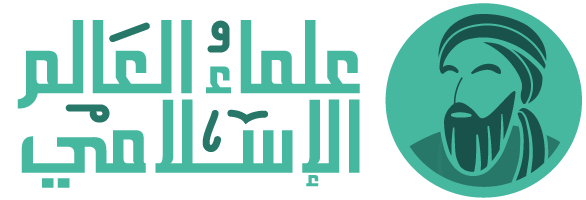ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المالكي، اُشتهر ابن خلدون بنسبته إلى جده خالد بن عثمان، وهو أول من دخل من هذه الأسرة إلى بلاد الأندلس، وعُرف فيما بعد باسم "خلدون"، وأصل هذه الأسرة يماني حضرمي، ولد ابن خلدون في إحدى دور تونس، وتقع حاليًا في شارع تربة الباي، ولا تزال هذه الدار قائمة. ...السيرة الذاتية
ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المالكي، اُشتهر ابن خلدون بنسبته إلى جده خالد بن عثمان، وهو أول من دخل من هذه الأسرة إلى بلاد الأندلس، وعُرف فيما بعد باسم "خلدون"، وأصل هذه الأسرة يماني حضرمي، ولد ابن خلدون في إحدى دور تونس، وتقع حاليًا في شارع تربة الباي، ولا تزال هذه الدار قائمة. ...السيرة الذاتية
وتشتمل على تعريف بعلم التاريخ والغرض الحقيقي منه، فهي شرح وتمهيد لقراءة التاريخ، ومحاولة لوضع نظريات عامة حول علم الاجتماع الإنساني وأثر البيئات في الطبائع البشرية، ومحاولة وضع نظرية عامة لتطور المجتمعات والثقافات الإنسانية. وتعتبر المقدمة على حد قول المؤرخ البريطاني الشهير "أرنولد توينبي": "إحدى أعظم ما أنجزه العقل البشرى في كل العصور". كما اعتبره البروفيسور "برنارد لويس" أستاذ الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي بجامعة السوربون أفضل مفكر عربي في العصور الوسطى، لما أضفاه من روح نقدية على الكتابة التاريخية، وتتناول المقدمة أيضًا الكلام على كل أنواع المعرفة وفروعها.
ويعرف بتاريخ ابن خلدون، ويشتهر اختصارًا باسم كتاب "العبر"، وتعتبر المقدمة السابقة مقدمة لهذا الكتاب غير أن الباحثين قد عالجوها كمؤلف مستقل لما تتميز به من طابع موسوعي. وهو مصدر مهم من مصادر تاريخ شمال أفريقيا والمغرب والأندلس في الفترة التي عاش فيها ابن خلدون وقام بدور في أحداثها، كما أنه يعتبر مصدرًا قيمًا للمعلومات فيما يتعلق بحياة القبائل العربية والبربر بالمغرب طوال فترة خمسين عامًا (النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي) وهى الفترة التي كان يتجول ابن خلدون خلالها بين ربوع هذه البلاد، وكان يدرس خلالها كتب تاريخ هذه البلاد ويدرس وثائق عصرها السياسية ويشارك في صنع أحداثها، بالمفاوضات مرة وبالضلوع في الدسائس والمؤامرات مرات. كما يشتمل كتاب العبر على معلومات عن تاريخ العرب قبل الإسلام، والدول الإسلامية المختلفة مثل: الأموية والعباسية والعبيدين "الفاطميين" والأيوبيين والمماليك، وتاريخ دول الإسلام في المشرق، وتاريخ الدول القديمة وتاريخ الممالك النصرانية، ويبدأ ابن خلدون تاريخه منذ بدء الخليفة، وكان هدفه كما قال هو وضع تاريخ مفصل للمغرب فقط، ولكن بعد رحلته إلى المشرق الإسلامي أتيحت له فرصة إثراء معلوماته وإكمال تجاربه عن المشرق فإذا بتاريخ المشرق يستأثر بضعفي تاريخ المغرب حجمًا.
وهو ذيل لكتابه العبر، يتحدث فيه عن سيرته الذاتية.


تعلم على يديه الفقه المالكي.
أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث والسيرة وعلوم اللغة, حيث كان إمام المحدثين والنحاة بالمغرب.
أخذ عنه الفلسفة والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية.
درس عليه العديد من الكتب مثل: كتاب التسهيل لابن مالك، ومختصر ابن الحاجب في الفقه.
تلقى العلم على يديه.
بدأ ابن خلدون مرحلة التعليم بحفظ القرآن الكريم وتجويده، وكان أبوه معلمه الأول مع العديد من الأساتذة الذين قرأ عليهم القرآن، وجوًده بالقراءات السبع وقراءة يعقوب (إحدى القراءات الثلاث الزائدة على القراءات السبع والمكملة للقراءات العشر)، إلى جانب العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه على المذهب المالكي وعلم الأصول وعلم التوحيد، وعلوم اللغة والمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية. وكان ابن خلدون متميزًا في جميع دراساته، كما كان وفيًّا لكل أساتذته حيث اعتنى بذكر أسمائهم والترجمة لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم العلمية ومؤلفاتهم، كما اهتم بذكر أهم الكتب التي درسها عليهم، ومنها: 1- كتاب اللامية في القراءات، وكتاب الرائية في رسم المصحف للشاطبي. 2- التسهيل في النحو لابن مالك. 3- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. 4- معظم كتب الحديث، وخاصة كتاب صحيح مسلم، والموطأ للإمام مالك بن أنس. 5- كتاب التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد البر. 6- كتاب السِّيَر لابن إسحاق. 7- كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. 8- كتاب التهذيب في مختصر مُدَوَّنة سَحْنون في الفقه المالكي لأبي سعيد البرادعي. 9- مختصري ابن الحاجب في الفقه والأصول. 10- طائفة من شعر أبي تمام والمتنبي. وعندما بلغ سن الثامنة عشر انقطع عن طلب العلم، وذلك بسبب وباء اجتاح معظم بلاد العالم سنة 749هـ/ 1348م، وهو ما نتج عنه هجرة معظم العلماء والأدباء من تونس إلى المغرب الأقصى، فتغير مجرى حياته وتطلع إلى تولي الوظائف العامة كما فعل أسلافه من قبل، حيث تولى العديد من الوظائف التي أسهمت بشكل كبير في تشكيل فكره وواقعية منهجه. وفي أواخر سنة 751هـ/ 1350م شغل وظيفة "كاتب العلامة" للسلطان أبي إسحاق بن أبي يحيى الحفصي، وتختص هذه الوظيفة بوضع "الحمد لله والشكر لله" بالقلم الغليظ مما بين البسملة وما بعدها في المخاطبات الرسمية باسم السلطان، وهي أول وظيفة تولاها من وظائف الدولة، وبعد سفره إلى مدينة فاس في سنة 755هـ/ 1354م عينه أبو عنان سلطان بني مرين عضوًا في مجلسه العلمي، وكلفه شهود الصلوات معه، وفي عام 756هـ/ 1355م عينه ضمن كُتَّابه ومُوَقِّعيه. وفي عام 757هـ/ 1356م اُتهم ابنُ خَلدون بمشاركته في مؤامرة مع الأمير "أبو عبد الله محمد الحفصي" حاكم بجاية المخلوع، والذي كان وقتذاك أسيرًا بمدينة فاس، فسجنه أبو عنان عامين، وبعد وفاة "أبو عنان" واستئثار الوزير "الحسن بن عمر" بالسلطة أطلق سراح ابن خلدون ورده إلى وظائفه السابقة، كما رفض "الحسن" طلب ابن خلدون في العودة إلى بلده. وفي عهد "منصور بن سليمان المريني" تولى وظيفة كاتب العلامة، وفي عهد "أبي سالم بن أبي الحسن" شقيق "أبي عنان المريني" تولى ابن خلدون وظيفة "كاتب السر والإنشاء والمراسيم" وجعله السلطان موضع ثقته وعطفه، ثم ولاه السلطان "خطة المظالم- تشبه وزارة العدل حاليًا" فأداها بعدالة وكفاءة. وفي عام 762هـ/ 1361م ثار رجال الدولة على السلطان "أبي سالم" بقيادة الوزير "عمر بن عبد الله"، وانتهت الثورة بخلعه وتولية أخيه "تاشفين" سلطانًا مكانه، واستبد الوزير "عمر بن عبد الله" بالأمر واستأثر بالسلطة، فأقر ابن خلدون في وظائفه وزاد في إقطاعه (مخصصاته المالية). واصطدم ابن خلدون في هذه المرحلة مع الوزير "عمر بن عبد الله" نتيجة عدم تحقيقه لرغبته في تحقيق طموحه بتولي وظيفة عليا، فاستقال ابن خلدون من وظائفه، وتوترت علاقته مع "عمر بن عبد الله" مما دفعه إلى طلب السفر، فأذن له بعد وساطة الوزير "مسعود بن رحُّو" على ألا يذهب إلى تلمسان، فاتجه ابن خلدون إلى غرناطة مارًّا بمدينة سبتة، وكان ذلك عام 764هـ/ 1362م. وعند وصوله إلى مدينة غرناطة أحسن إليه السلطان "محمد بن يوسف بن الأحمر" ووزيره "لسان الدين ابن الخطيب"، وقربه السلطان إليه واختصه عام 765هـ/ 1364م بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة "بطرة بن الهنشة بن أذفونش" لعقد صلح بينهما وتنظيم العلاقات السياسية بين المدينتين، فنجح ابن خلدون في مهمته فكافأه السلطان، فزاد ثراؤه فاستأذن من السلطان في استقدام أسرته من مدينة قسنطينة، فأذن له. ونتيجة للوشايات حدثت فجوة بين السلطان وابن خلدون، فأدرك أنه لم يبق له مُقامٌ في غرناطة وأنه لا بديل له من الرحيل عن الأندلس كلها، ووافق ذلك قدوم رسالة من أمير بجاية "أبي عبد الله محمد الحفصي" بعد نجاحه في استرداد عرش بجاية سنة 765هـ/ 1364م، حيث كتب إلى ابن خلدون يستدعيه من غرناطة ليتولى حجابته (تعادل رئاسة الوزراء حاليًا) فعرض ابن خلدون ذلك على سلطان غرناطة واستأذنه في السفر فأذن له، وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة 766هـ/ 1365م. وصل ابن خلدون إلى بجاية وتولى الحجابة لأميرها الذي استقبله استقبالًا حافلًا هو وأهل المدينة، كما تولى الخطابة بجامع القصبة إلى جانب تدريس العلم أثناء النهار بالجامع نفسه، ونجح في تدبير أمور ومعالجة الفتن بدهاء وصرامة متجولًا بين القبائل البدوية لجمع الضرائب منها. ولم تستقر الأمور حيث نشبت الخصومة بين الأمير "أبي عبد الله" أمير بجاية وابن عمه السلطان "أبي العباس أحمد" أمير قسنطينة الذي كان يتطلع إلى امتلاك بجاية، ونجح في دخول بجاية وقتل أميرها سنة 767هـ/ 1366م، فخرج ابن خلدون إلى السلطان "أبي العباس" ومكنه من البلد، فأقره في منصب الحجابة فترة ثم ارتاب من ابن خلدون فعزله، فخاف ابن خلدون منه واستأذنه في الانصراف إلى أحد الأحياء القريبة منه، فأذن له، وحاول بعد ذلك القبض على ابن خلدون ففر منه إلى مدينة بسكرة، وقبض "أبو العباس" على الأخ الأصغر لابن خلدون "يحيى"، واستقر ابن خلدون في بسكرة يرقب الأحداث من منتصف عام 767هـ/ 1366م حتى عام 776هـ/ 1375م قضاها بعيدًا عن وظائف الدولة. ثم سافر إلى غرناطة ونزل في ضيافة سلطانها ابن الأحمر، لكنه لم يستقر وعاد سريعًا إلى تلمسان فقدمها في عيد الفطر عام 776هـ/ 1375م، وعقد العزم على اعتزال السياسة والتفرغ للعلم، لكن السلطان كلفه بمهمة دعوة القبائل، فتظاهر ابن خلدون بالقبول، وغادر تلمسان متجهًا إلى قلعة بني سلامة في وهران ولحقت به أسرته، بعد أن نجح بعض الوسطاء في إقناع السلطان بالعفو عنه لمخالفته أمره، فاستقر بها نحو أربعة أعوام تفرغ فيها للدراسة والتأليف، فصنف مؤلَّفه التاريخي الشهير المعروف باسم "مقدمة ابن خلدون"، وانتهى من كتابته في منتصف سنة 779هـ/ 1377م. ثم سافر إلى تونس مسقط رأسه، وظل عاكفًا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم مؤلفه ونقحه وهذبه، وأهدى نسخته إلى السلطان "أبي العباس" في أوائل سنة 784هـ/ 1382م فتقبلها السلطان وأثنى عليها، وكان السلطان قد اصطحب معه ابن خلدون سنة 783هـ/ 1381م في حملة حربية على "يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول" أمير توزر ليسترد منه مدينة توزر، فأدرك ابن خلدون أن عليه أن يغادر وللأبد مسقط رأسه، فاستأذن في الرحيل طلبًا للحج حيث أقلته السفن البحرية عبر البحر المتوسط إلى مدينة الإسكندرية، فوصلها يوم عيد الفطر عام 784هـ/ 1382م، واستقر بها شهرًا، قصد بعدها مدينة القاهرة، فما إن وصلها حتى أقبل عليه العلماء، وخاصةُ أهلِها والطلاب يلتمسون من علمه، وبدأ بإلقاء دروسه في الجامع الأزهر، ثم عينه السلطان المملوكي الجركسي "الظاهر برقوق" في تدريس الفقه المالكي بالمدرسة القمحية، بجوار جامع عمرو بن العاص في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 786هـ/ 1384م، وقد أسس ابن خلدون في مصر مدرسة نسجت على منواله في بحوثها العلمية واتجاهاتها المنهجية، ويعتبر المقريزي أشهر رواد هذه المدرسة. وفي التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة 786هـ/ 1384م تولى ابن خلدون منصب قاضي قضاة المالكية بالديار المصرية، ولُقب ب “ولي الدين"، وأعفاه السلطان "الظاهر برقوق" في جمادى الأولى عام 787هـ/ 1385م، وفي عام 788هـ/ 1386م عينه السلطان "الظاهر برقوق" أستاذًا للفقه المالكي في مدرسته بالقاهرة. وفي عام 789هـ/ 1387م قصد الحج إلى بيت الله الحرام، وعاد إلى مصر في الرابع عشر من جمادى الآخرة عام 790هـ/ 1388م. وفي شهر المحرم عام 791هـ/ 1389م عينه السلطان "الظاهر برقوق" أستاذًا للحديث بمدرسة الأمير صرغتمش، وفي السادس عشر من شهر ربيع الآخر عام 791هـ/ 1389م تولى مشيخة خانقاه ركن الدين بيبرس، ثم أعيد إلى منصب قاضي قضاة المالكية مرة ثانية في شهر رمضان عام 801هـ/ 1399م، وقام برحلة إلى بيت المقدس بعد أن استأذن السلطان "الناصر فرج بن برقوق" في ذلك، وعاد منها في أواخر شهر رمضان عام 802هـ/ 1399م، وفي الثاني عشر من شهر المحرم سنة 803هـ/ 1400م أعفي من منصب القضاء بسبب وشاية. وعندما استولى "تيمور لنك" على بلاد الشام سنة 803هـ/ 1400م خرج السلطان المملوكي "الناصر فرج بن برقوق" لملاقاته، وانتهت الأمور بالمفاوضات بين الجانبين، وقد قام ابن خلدون بدور مهم في هذه المفاوضات، ويبدو أن تيمور لنك قد أعجب بعلمه الواسع في التاريخ والجغرافيا، وظل فترة قصيرة مع تيمور لنك في دمشق ثم عاد إلى القاهرة. ثم أعيد إلى منصب القضاء مرة ثالثة في شهر رمضان عام 803هـ/ 1400م، ثم أعفي منه في شهر جمادى الآخرة سنة 804هـ/ 1401م، ثم أعيد إلى منصب القضاء مرة رابعة في شهر ذي الحجة عام 804هـ/ 1402م، ثم أعفي منه في السابع من شهر ربيع الأول سنة 806هـ/ 1403م، ثم أعيد للمرة الخامسة والأخيرة إلى منصبه في شهر شعبان 807هـ/ 1405م، إلى وفاته في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 808هـ/ 1406م.
تعليق
علماء قد تهمك
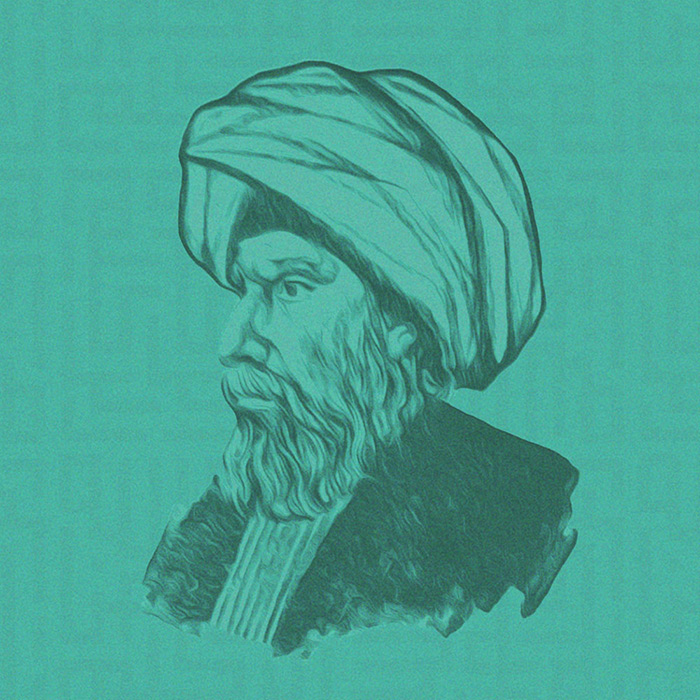
الإمام الشافعي
ت: 204 هـ | عربي الأصل | العصر العباسي

البتاني
ت: 317 هـ | العصر العباسي

زينب بنت الكمال
ت: 740 هـ | عربي الأصل | دولة المماليك البحرية

ابن فضل الله العمري
ت: 749 هـ | عربي الأصل | دولة المماليك البحرية
يلقي موقع علماء العالم الإسلامي الضوء على سيرة وإسهامات علماء العالم الإسلامي، ودورهم في الحضارة الإنسانية. ويضم الموقع مجموعة كبيرة من أهم العلماء شرقًا وغربًا، وفي مختلف مجالات العلوم العقلية والنقلية. ....المزيد